تيموثاوس الأولى 1 - تفسير رسالة تيموثاوس الأولى
الوصية غاية الرعاية للقمص تادرس يعقوب ملطي
يبدأ الرسول بالبركة الرسولية كعادته، موضحًا للقديس تيموثاوس خطورة عمله الرعوي في أفسس ألا وهو تقديم الوصية الإلهية، وتحذير المؤمنين من أصحاب الخرافات والمباحثات التي ليست للبنيان، معلنًا له عن غاية رسالته خلال حديثه عن نفسه، حاثًا إياه على الجهاد الروحي في الخدمة الإلهية.
1. البركة الرسولية
١ - ٢.
2. غاية الوصية
٣ - 11.
ما هي الأنساب؟
3. الالتزام بالخدمة
١٢ - ١٧.
4. الجهاد في الخدمة
١٨ - ٢٠.
1. البركة الرسولية
"بولس رسول يسوع المسيح
بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا،
إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان،
نعمة ورحمة وسلام من أبينا والمسيح يسوع ربنا" [١-2].
يقدم الرسول في هذه الافتتاحية البركة الرسولية لتلميذه تيموثاوس بما يناسب احتياجاته والظروف المحيطة به، إذ يُلاحظ فيها الآتي:
أ. إذ يكتب إلى خادم ملتزم بالكرازة وسط أتعاب وضيقات أراد الرسول تأكيد أن الخدمة التي يتسلمها ليست من إنسان بل من الله الآب الذي قدم ابنه الوحيد لخلاص البشرية، ومن الابن نفسه أيضًا، إذ يقول: "بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح". وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [من البداية يرفع بولس نفس تيموثاوس ويشجعها، بقوله أن الله مخلصنا والمسيح رجاؤنا. إننا نتألم كثيرًا، لكن رجاؤنا عظيم! إننا نتعرض لفخاخٍ ومخاطرٍ، لكن الذي يخلصنا هو الله لا الإنسان. مخلصنا ليس بضعيفٍ، إذ هو الله، فلا تهزمنا المخاطر أيًا كانت، ورجاؤنا لن يخيب، إذ هو المسيح[15].]
إننا كخدام مُرسلين من قبل الله الآب الباذل ابنه عن البشرية والابن المبذول عنا لخلاصنا يليق بنا أن نقدم حياتنا نحن أيضًا مبذولة بالحب من أجل كل نفس.
في وسط الآلام يرى نفسه "رسولًا" أي مبعوثًا أو سفيرًا عن الله، لا عمل له سوى الشهادة له بحياته كما بكرازته، وقد قبل هذا العمل "بأمر الله" وقد جاءت كلمة "أمر" في اليونانية لتعني الأمر الملوكي العسكري الذي لا رجعة فيه، فيلتزم بالعمل لتتميم هذا الأمر الإلهي. لقد صدر الأمر حينما أفرزه الله وهو في بطن أمه (غل ١: ٥)، كما أكده بأمر كنسي، حين قال الروح: "افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه" (أع ١٣ : ٢)، حيث صامت الكنيسة وصلت ووضع التلاميذ الأيدي عليهما.
ب. في هذه الافتتاحية يبرز الرسول دور الآب كمدبر للخلاص، ومُرسل الرسل، وواهب النعم والرحمة والسلام، حتى يؤكد وحدة العمل بين الآب والابن، وكما يقول القديس أمبروسيوس [انظر كيف أن مملكة وأمر الآب والابن هما واحد[16].] بهذا يهدم الرسول ثنائية الغنوسيين الذين يفرقون بين إله العهد القديم، وإله العهد الجديد. فإن كان الرسول بولس يعشق اسم ربنا يسوع المسيح، حتى أنه يكرره ثلاث مرات في هذه الافتتاحية القصيرة، لكنه يعرف ربنا يسوع بكونه الابن الذي قدمه الآب في محبته لخلاصنا، وخلاله ننعم بكل عطايا الآب ونعمه.
ج. إذ يتحدث عن الآب والابن لا يتحدث عن علاقتهما معًا خارجًا عنا، إنما نعرفهما خلال عملهما معًا من أجلنا ولحسابنا، فيدعو الآب أبانا ومخلصنا المسيح ربنا ورجاءنا... وكأن الرسول لا يريد أن يقدم لنا معرفة لاهوتية نظرية تقوم على الحكمة البشرية العقلية وإنما يريد أن نتعرف عليها كسّر حياتنا وخلاصنا وكمالنا.
د. يكرر الرسول في رسائله الرعوية كلمة "مخلصنا" أكثر من غيرها من الرسائل، ليؤكد للراعي أن عمله الرئيسي هو توجيه الرعية إلى مخلصها، وليوضح ضرورة اهتمام الراعي بالعمل الخلاصي فوق كل عمل آخر.
ه. يدعو القديس تيموثاوس "الابن الصريح في الإيمان"، وقد جاءت كلمة "صريح" في اليونانية gensios بمعنى الابن الأصيل أو الحقيقي غير الزائف أو الشرعي. فقد ولده الرسول بعد أن تمخض به خلال أتعاب الكرازة بالإنجيل (١ كو ٤: ١٤-١٦؛ في ١٠)، الابن الروحي الذي يعتز به. يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا التعبير بالقول: [لا يوجد بينهما اختلاف، فقد حمل تيموثاوس شبهًا له في الإيمان، وذلك كما يحدث في المواليد، حيث يوجد شبه في كيان (الوالد والمولود منه)[17].]
يعتز الرسول بأبوته الروحية لشعب الله، إذ يقول: "لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل" (١ كو ٤: ١٥). هذه الأبوة ليس شرفية، لكنها ملزمة بالمسئولية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم لأولاده الروحيين: [أني أحبكم حتى أذوب فيكم، وتكونون لي كل شيء: أبي وأمي وإخوتي وأولادي![18]]
إن كان الرسول هو أب للقديس تيموثاوس، فإن هذه الأبوة الروحية تنبع عن أبوة الله للبشرية كلها، لذا يدعو الله "أبانا". خلال هذه الأبوة يستريح بحق تيموثاوس كما بولس أيضًا، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [هنا توجد تعزية، فإن كان الله أبانا [٢] فهو يهتم بنا كأبناء، كما يقول المسيح: "أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزًا يعطيه حجرًا؟ (مت ٧ : ٩)[19].]
و. في رسائله غير الرعوية غالبًا ما يكتفي الرسول في البركة الرسولية، أما هنا فيضيف "الرحمة"، وبالعبرية chcsedh، وقد تكررت ما لا يقل عن ١٢٧ مرة في سفر المزامير كموضوع تسبيح الشعب. لقد قدم الله لنا مراحمه ونحن بعد أعداء، فانتشلنا من حالة العداوة إلى البنوة له، ومن الظلمة إلى النور. لذا يليق بنا أن نرد رحمته بالرحمة نحو الآخرين، ويسلك الخدام بروح سيدهم! ويرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن المعلمين محتاجون إلى إدراك مراحم الله وسط الخدمة بسبب الأتعاب التي يعانون منها. هذا وقد سلك الرسول نفسه بالرحمة أيضًا مع تلميذه تيموثاوس، فنراه يشفق عليه، قائلًا: "لا تكن في ما بعد شّراب ماء بل استعمل خمرًا قليلًا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة" (١ تي ٥: ٢٣).
ز. يُلقب السيد المسيح "رجاؤنا"، هكذا كانت الكنيسة الأولى تتمسك بهذا اللقب، ليس لأننا نترجى أن ننال شيئًا فيه وإنما أنه نناله هو. ليس فقط باب الرجاء لكنه موضوع الرجاء نفسه، ففيه نلناه كثير كّسر حياتنا وخلاصنا وأبديتنا!
يقول القديس أغناطيوس الأنطاكي: [افرحوا في الله الآب وفي المسيح يسوع رجائنا المشترك[20].] ويقول القديس بوليكريس: [فلنثبت إذًا في رجائنا وفي ضامن برنا... يسوع المسيح.] ففيه رجاؤنا، حيث ننعم بالطبيعة الجديدة في استحقاقات دمه، بدفننا معه في المعمودية، وفيه ننعم بالنصرة علي الموت وندخل الحياة الأبدية، وفيه ندخل إلى حضن أبيه السماوي لنوجد معه ممجدين.
2. غاية الوصية
أوضح الرسول التزام القديس تيموثاوس بتوجيه المؤمنين في أفسس أن يتجنبوا التعاليم الغريبة والمباحثات الغبية التي ليست للبنيان الروحي، قائلًا له: "كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبًا إلى مكدونية، لكي توصي قومًا أن لا يعلموا تعليمًا آخر، ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها، تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان" [٣-٤].
جاءت كلمة "طلبت" في اليونانية بمعنى يطلب أو يتوسل باشتياق، وكأن الرسول لا يميل إلى إصدار أوامر إنما يقدم توسلات لتلميذه. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لاحظ لطف التعبير، إنه يستخدم أسلوب العبد لا السيد[21].]
يطالبه أن يوصي قومًا بأفسس ألاَّ يعلموا "تعليمًا آخر"، وفي اليونانية "تعليمًا غير أرثوذكسي[22]"، أي "غير مستقيم"، قاصدًا الذين يفسرون كلمة الحق بانحراف. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم هكذا: [إنه لم يذكر أشخاصًا بأسمائهم حتى لا يدخل بهم إلى خزي أكثر خلال التوبيخ المباشر المكشوف. لقد وجد الرسول في المدينة بعضًا من رسل اليهود البطالين الذين أرادوا أن يلزموا المؤمنين بحفظ الناموس الموسوي، الأمر الذي عالجه الرسول في رسائله الأخرى. هؤلاء كانوا يعملون بلا دافع من ضمائرهم بقدر ما كان دافعهم المجد الباطل، إذ أرادوا أن يكون لهم تلاميذ، وكانوا يحسدون بولس الطوباوي ويقاومونه[23].]
ما هي الخرافات التي يطالبهم الرسول بعدم الإصغاء إليها؟ ربما قصد ما كتبه للقديس تيطس: "لا يصغون إلى خرافات يهودية، ووصايا أناس مرتدين عن الحق" (تي ١: ١٤). هذا بالنسبة للذين هم من أصل يهودي، أما بالنسبة للذين هم من أصل أممي، فيحذرهم من الأساطير الخرافية التي اتسمت بها الثقافات اليونانية والرومانية والفارسية الخ.، حيث تروي قصصًا عن نزول الآلهة إلى هذا العالم لتتزوج من بنات الناس وينشئوا بذلك فرعًا يمتد أصله إلى السماء.
وما هي الأنساب؟
أولًا: ربما قصد بها الأنساب اليهودية، فكان البعض ممن قبلوا الإيمان المسيحي يعتزون بأنهم من أصل كهنوتي أو من سبط يهوذا الخ.، فيسقطون في المجد الباطل.
ثانيًا: كان في العالم الأممي القديم اهتمام خاص بالأنساب، نذكر على سبيل المثال اسكندر الأكبر، صُنعت له شجرة نسب تعود إلى آشيل Achilles واندروماك Andromache من جانب وإلى برسسPerseus وهرقل Herclues من جانب آخر. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن اليونان كانوا يعددون آلهتهم خلال أنساب معينة.
ثالثًا: يرى القديس إيريناؤس[24] والعلامة ترتليان[25] أن الأنساب هنا تشير إلى بذور الهرطقات الغنوسية التي اعتقد بعضهم أن الكائن الأعظم قد انبثق عنه كائن، وهذا انبثق عنه ثالث، وهكذا حدثت عدة انبثاقات تسمى الأيونات، هذه التي ضعفت من نسب إلى آخر، وأن الإنسان يبلغ إلى الكائن الأعظم خلال هذه الوسائط بواسطة المعرفة gnosis[26].
أما قول الرسول عن هذه الأمور أنه "لا حد لها" قصد أنها بلا نهاية أو بلا غاية أو هدف يبلغه الإنسان خلالها.
والآن، ماذا يعني الرسول بقوله: "مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان"؟ هل يرفض الرسول البحث والمناقشة في الأمور الإيمانية؟
لقد اهتم الغنوسيون بالمعرفة ليست النابعة عن حب الحق والمتسمة بروح متواضع تقوي، وإنما "المعرفة" المتعجرفة التي تهتم بالمباحثات الجافة العقيمة التي بلا حياة. يهدفون إلى المجادلات لأجل ذاتها، بعيدًا عن الحياة التقوية. فاحتلت المعرفة موضع الإيمان كطريق الخلاص. هذه هي "المباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان"، أما المباحثات التي للبنيان فهي التي تدخل تحت دائرة الإيمان، تصدر عن نفس متواضعة تطلب الحق لا للجدال والمناقشة وإنما لتحيا به وتمارسه.
يقول القديس إيريناؤس عن هؤلاء المعلمين: [إنهم يفسدون تعاليم الله، ويثبتون أنفسهم كمفسرين أشرار لكلمة الإعلان الصالحة، يحطمون إيمان الكثيرين بانتزاعهم عن الإيمان تحت ستار المعرفة... يخدعون البسطاء بالكلمات المنمقة والشكل الحسن، محطمين إياهم بسماجة[27].] ويتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن المباحثات الغبية قائلًا: [يلزمنا إلاَّ ننشغل بالمباحثات، لأننا إذ نسأل لا يكون للإيمان موضع، إذ الإيمان يعطي للمباحثات هدوءً. لكن لماذا يقول السيد: "اطلبوا تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم" (مت ٧: ٧)؟ وأيضًا "فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية" (يو ٥: ٣٩)؟ الطلب يعني الصلاة والرغبة الشديدة. فهو يأمر بتفتيش الكتب لا للدخول في أتعاب المباحثات وإنما لإنهائها، بالتأكد من معناها الحقيقي، فلا نبقى بعد في مباحثات مستمرة وإنما نقطع فيها[28].]
ما نريد تأكيده أن الإيمان يرفض المباحثات الغبية، لكنه يلتقي مع المباحثات البناءة التي تقوم بروح الإخلاص والشوق الحقيقي لمعرفة الحق والتمتع به تحت قيادة روح الله القدوس. وقد قامت مدرسة الإسكندرية المسيحية منذ بدء انطلاقها تصالح الإيمان مع الفلسفة، وتزوج القلب مع الفكر[29].
يعالج القديس بولس حب الدخول في المباحثات الغبية التي يثيرها الهراطقة بقصد الكبرياء والتمتع بالسلطة، بتحديد هدف الرعاية، ألا وهو تقديم الوصية الإنجيلية بروح الحب الخالص العملي، إذ يقول: "وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء" [٥]. خارج الحب تفقد الوصية وجودها وينحرف المعلمون عن رسالتهم، فتتحول إلى مباحثات غبية تسبب انشقاقات في الجماعة. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إذ لا يحب الناس يحسدون من لهم صيت حسن، مشتاقين أن ينالوا السلطة، وبحبهم للسلطة يقدمون الهرطقات[30].]
"المحبة" هي غاية الوصية التي يكرز بها الرسل وكل خدام الكلمة، هذه التي تشبع القلب، وتحدد هدف الإنسان، فلا يرتبك بالمناقشات الباطلة، ولا يعطي لنفسه سماحًا أن تهتم بالمباحثات غير البناءة. يحدد الرسول سمات هذه المحبة، بأنها تصدر عن "قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء".
* "وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء"(1 تي 1:٥)...لكن أي نوع من المحبة يتحدث عنها الرسول؟ المحبة الخالصة التي لا تقوم على كلمات مجردة، إنما تنبع عن الميل الداخلي والوجدان والعاطفة، إذ يقول: "من قلب طاهر..." فالحياة الشريرة تجلب انقسامات، "لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور" (يو ٣: ٢٠). حقًا توجد صداقات حتى بين الأشرار، فالقتلة واللصوص يحبون بعضهم البعض، لكن ليس من ضميرٍ صالح ولا من قلبٍ طاهر، إنما قلب دنس، وليس من إيمانٍ بلا رياء وإنما من إيمانٍ باطلٍ مراءٍ... فالإيمان يشير إلى الحق... ومن يؤمن بالله حقًا لا يقدر أن يبتعد عنه[31].
القديس يوحنا الذهبي الفم
لقد أحبت امرأة فوطيفار الشاب يوسف لكن بقلب غير طاهر، فلم تنفذ الوصية، إذ كانت تحب شهوات نفسها... وإذ حرمها يوسف ألقت به في السجن. وأحب أمنون أخته ثامار جدًا حتى مرض، وعندما لم تشبع شهواته أبغضها جدًا وجعلها في عارٍ. لذا يصر الرسول أن تكون المحبة "من قلب طاهر"، تنبع عن قلب تقدس بسكنى الله القدوس فيه، وضمير صالح أي نية أو إرادة صالحة فلا يداهن ولا يعمل بخبث، وإيمان بلا رياء... أي تنبع محبته للإخوة خلال إيمانه بالله وحبه له. وكما يقول القديس أغسطينوس: [لا يوجد حب حقيقي به نحب الآخرين ما لم نحب الله. كل إنسان يحب قريبه كنفسه، إن كان محبًا لله، لكنه إن لم يحب الله فلا يحب نفسه[32].] في اختصار نقول أنه بالحب الحقيقي لله خلال إيماننا به وسكناه فينا يحب كل منا نفسه في الرب، كهيكلٍ مقدس له، عندئذ يقدر أن يحب أخاه كنفسه! هذا هو الحب القادر أن يشبع القلب والفكر وكل الأحاسيس، فلا يجد الإنسان مجالًا للمباحثات الفارغة!
يكمل الرسول "الأمور التي إذ زاغ قوم عنها، انحرفوا إلى كلام باطل" [٦]. حقًا إذا زاغ إنسان عن الحب الإلهي الصادق تتحول حياته الداخلية إلى فراغ بلا شبع، فيتحول عن الحق إلى الكلام الباطل والمباحثات التي بلا هدف، لعلها تغطي العجز الداخلي. يتحول الإنسان عن الحياة التقوية والشهادة العملية إلى شهوة التعليم وبلوغ السلطة بلا فهم ولا حكمة، لهذا يكمل الرسول: "يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا يقررونه" [٧]. ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا النص قائلًا: [نجد هنا سببًا آخر للشر، وهو شهوة السلطة. لذلك يقول المسيح: "أما أنتم فلا تدعوا سيدي Rabbi" (مت ٢٣: ٨)، كما يقول الرسول: "لا يحفظون الناموس... إنما لكي يفتخروا في جسدكم" (غل ٦: ١٣)، أي أنهم يطلبون الكرامة دون أن يهتموا بالحق. "وهم لا يفهمون ما يقولون ولا يقرونه" [٧]. إنه يوبخهم إذ لا يعرفون غاية الناموس ولا الوقت اللازم لنوال السلطان. لكن إن كان هذا عن عدم فهم، فلماذا تُحسب عليهم خطية؟ لأن ما يحدث لا ينبع عن اشتياق فيهم أن يكونوا معلمين للناموس، وإنما عن عدم إيجاد الحب. جهلهم ذاته نابع عن ذات السبب، فالنفس التي تتدنس بالأمور الجسدانية تنطمس فيها نقاوة الرؤية، وبسقوطها عن الحب تسقط في كثرة الخصام وتصاب عينا ذهنها بالعمى... ولا تقدر أن يكون لها الحكم الحق[33]".]
إذن في اختصار، انحرافهم عن الحب الحقيقي، دخل بهم إلى حالة من الفراغ الداخلي، أرادوا معالجته بالظهور كمعلمين للناموس ومدافعين عنه مع أنهم بعيدون عن غايته الحقيقية. وصارت حياتهم تتسم بكثرة المناقشات والمجادلات، ليس رغبة في البلوغ بأنفسهم وبغيرهم للحق، وإنما من أجل تمتعهم بالسلطة وحب الرئاسة. ولئلا يفهم القارئ أن الرسول يتهم الناموس في ذاته أو التعليم به كأمرٍ غير صالح، أكد: "ولكننا نعلم أن الناموس صالح، إن كان أحد يستعمله ناموسيًا" [٨]. فالخطأ ليس في الناموس، وإنما في إساءة استعماله. يشبههم القديس أغسطينوس بابنتي لوط اللتين أساءتا التصرف مع أبيهما فأنجبا لنا موآب وبني عمون الذين يشيران إلى الأعمال الشريرة، وكانا هما ونسلهما سرّ متاعب لا حصر لها لشعب الله. كما يقول القديس في نفس الموضع: [لم تصدر المتاعب الرئيسية للكنيسة إلاَّ عن الذين يسيئون استخدام الناموس[34].]
ظن بعض المسيحيين الذين من أصل يهودي أن الرسول بولس يتحدث ضد الناموس (أع ٦: ١٣-١٤)، لهذا كان يؤكد بكل وضوح أنه صالح ومقدس (رو ١٢: ١٢) إن استعملناه ناموسيًا، أي أدركنا أن "غاية الناموس هي المسيح للبرّ لكل من يؤمن" (رو ١٠: ٤)، أو كما يقول: "كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان" (غل ٣: 2٤)، إن قبلنا ابن الله "مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني" (غلا ٤: ٤-٥). لقد أخذنا الناموس لا لندخل في مباحثات غبية، وإنما لكي يدين الخطية العاملة فينا، فنقبل السيد المسيح مبرر الخطاة، يحررنا من حكم الموت الذي صار علينا بالناموس. لهذا يقول الرسول: "فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" (رو ٦: ١٤)، "لأني مت بالناموس لأحيا لله" (غلا ٢: ١٩)، "ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقًا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن، إذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب" (غل ٣: ٢٣). "ولكن إذا انقدتم بالروح، فلستم تحت الناموس" (غلا ٥: ١٨).
يتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن دور الناموس، قائلًا: [إن استخدمت الناموس بطريقة سليمة، يقودك إلى المسيح. فإن كان هدفه هو تبرير الإنسان، لكنه يعجز عن تحقيق ذلك، فإنه يقدمك إلى القادر على تحقيق ذلك[35].] لكن إذ ندخل إلى السيد المسيح، وننعم بالحياة المعطاة لنا فيه بالروح القدس، إنما ننعم بما عجز عن تقديمه لنا بالناموس، فلا حاجة للعودة إلى السقوط تحت الناموس من جديد. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إن الفارس يستخدم اللجام في ضبط الفرس في البداية، لكن متى سلك بانضباط فلا حاجة للجام. والطفل يتعلم الحروف الأبجدية لكن متى صار ماهرًا في القراءة فلا عوز للعودة إلى الأبجدية. هذا هو استعمال الناموس ناموسيًا، أي تحقيق هدفه فينا فنعلو على الناموس ولا نبقى تحته. "الذين هم فوق الناموس ليسوا بعد في مدرسة الناموس، إنما يحفظونه بدخولهم إلى درجة أعلى، ويتممونه خلال ميلهم للفضيلة، وليس عن خوف... فمن يعيش فوق الناموس يستعمله ناموسيًا[36].] بمعنى آخر استخدام الناموس ناموسيًا هو الدخول في الحياة الفاضلة في المسيح يسوع، فلا نبقى تحته، ولا يتحول في حياتنا إلى مباحثات ومجادلات نظرية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إن كان أحد يتممه بتصرفاته يكون قد تممه ناموسيًا، إنما يستخدمه لنفعه الخاص[37].]
بهذا نفهم الناموس أنه مُقدم للاثمة والأشرار، لكي يقودهم إلى السيد المسيح كمخلصٍ لهم، يهبهم الحياة الفاضلة فيه، ويرتفع بهم إلى ما فوق الناموس. لهذا يقول الرسول: "عالمًا هذا أن الناموس لم يُوضع للبار، بل للاثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزناة لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين الحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه" [٩-١١].
الشرور المذكورة هي أبشع أنواع الخطية المفسدة للنفس التي تقاوم الحياة المقدسة في الرب حسب إنجيل مجده. وقد جاء الناموس من أجل مرتكبيها ليتعرفوا على عجزهم الذاتي التام، فيقبلوا على السيد المسيح ليس كغافر لهم هذه المعاصي المرة فحسب، وإنما ليدخل بهم إلى "مجد الله المبارك" خلال إنجيل خلاصه المجاني. هذا الإنجيل المجيد الذي أؤتمن عليه الرسول يُقدم للأشرار خلال الناموس الذي فضحهم وأعلن بؤسهم.
ويرى القديس أمبروسيوس أن الناموس هام ليس للأبرار بل للأشرار، لأن الأولين يمكن أن ينسحبوا للحياة الفاضلة خلال ناموس ذهنهم، أما الأشرار فيردعهم الناموس خلال الخوف من العقوبة[38].
من جانب آخر، إن كان الرسول يكتب إلى تلميذه تيموثاوس أن موضوع كرازته هو الوصية التي غايتها "المحبة"، فإن هذا الحب يفتح قلبنا لنرى الناموس مقدمًا لأشر الطبقات وأدنسها، ليدخل بها إلى مجد إنجيل الله. وكأن الرسول يوصي تلميذه بالحب لكل إنسان، خاصة الأشرار حتى يقتنصهم من شرهم إلى الحياة الإنجيلية المباركة. لا يقول هنا "الأشرار" بل يحدد الأشرار هكذا:
الأثمة والمتمردون، أي كاسرو الوصية عن عمدٍ، وليس عن ضعفٍ أو في جهلٍ...
الفجار، أي محبو الخطية، الذين يرتكبون آثامهم بجسارة في غير حياءٍ أو خجلٍ!
المستبيحون، أي الذين يشربون الإثم كالماء، دون أدنى إثارة لضمائرهم!
قتلة الآباء والأمهات، يمثلون أقسى أنواع القلوب، إذ هم أشر من الوحوش الكاسرة التي لا تؤذي والديها!
مضاجعو الذكور، أدنس أنواع الزنا والنجاسة، يصنعون النجاسة خلافًا للطبيعة!
سارقو الناس، وهم أشر اللصوص، يخطفون البشر ليبيعوهم كعبيد (خر ٢١: ٦؛ تث ٢٤: ٧).
الحانثون، الذين يرتكبون ألعن أنواع الكذب.
مقاومو التعليم الصحيح، هؤلاء الذين لا يصنعون الشر فحسب، وإنما يقاومون الحق.
من أجل هؤلاء وأمثالهم قدم الله ناموسه، ليدخل بهم إلى الشعور بالحاجة إلى مخلصهم، فكم بالحري يليق بنا أن نفتح قلوبنا بالحب نحوهم، دون الاستهانة بهم أو اليأس من خلاصهم.
3. الالتزام بالخدمة
إن كانت الوصية غايتها المحبة، هذه التي تفتح قلوبنا بالحب للجميع، فيهتم الراعي بالآثمة والفجار والمستبيحين الخ. فإن هذا العمل ليس فضلًا من جهة الراعي نحو الرعية، إنما أشبه برد الدين، إذ يقابل الراعي محبة الله له بحبه لشعب الله. هذا هو سرّ التزامنا بالخدمة، أنه أحبنا أولًا، فنلتزم أن نحبه في أولاده.
يقدم الرسول بولس نفسه مثلًا عمليًا لعمل الله في حياته، قائلًا: "وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، أنه حسبني أمينًا، إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلًا مجدفًا ومضطهدًا ومفتريًا، لكنني رُحمت، لأني فعلت بجهلٍ في عدم إيمان" [١٢-١٣]. يقدم الرسول بولس تسبحة شكر لله الذي لما رآه يهوي في الموت بتجديفه واضطهاده كنيسة الله وافترائه، لم ينقذه فحسب، وإنما أقامه خادمًا مؤتمنًا على الحق. لم يغفر له ماضيه فحسب، وإنما أقامه سفيرًا له. كثيرًا ما كان الرسول يعلن ما كان عليه قبلًا كمضطهدٍ ومفترٍ (أع ٢٢: ٧)، ليعلن تفاضل نعمة الله المجانية عليه، منكرًا كل استحقاق شخصي في قيامه بالخدمة، ناسبًا كل الفضل لله، ولكن دون تجاهل لحرية الإرادة الإنسانية التي يقدسها الله. إنه مدين كل الدين لنعمة الله التي تفاضلت جدًا فأقامته للخدمة، إذ يقول "قواني" أي وهبني "قوته الإلهية" لكي أرد الدين بالحب نحو الذين لم يختبروا بعد عمله الخلاصي، ولكي لا أيأس قط من خلاص إنسان! يقول القديس أغسطينوس: [إذ نال بولس عفوًا عن جرائم عظيمة هكذا، يليق ألاَّ ييأس أحد من أي خطية، فإنها تُغفر له![39]]
لقد أدرك الرسول بولس أنه قد "رُحم"، فما يناله من نعم هو من قبيل مراحم الله المجانية... وكما يقول القديس أغسطينوس: [إنه يقول بأنه رُحم ليس خلال استحقاقاته الذاتية، وإنما خلال مراحم الله[40].] ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لاحظ كيف يشكر الله، إذ يعرف أن حتى ما يفعله من جانبه، إنما هو فضل من الله الذي جعله أناءً مختارًا[41].]
في تواضع يعترف الرسول بولس أنه كان مجدفًا ومضطهدًا ومفتريًا، فلماذا دعاه الله للخدمة دون غيره من المجدفين والمضطهدين والمفترين؟ يجيب القديس يوحنا الذهبي الفم: [لأن ما فعلوه لم يكن بجهل، وإنما بإرادتهم عن معرفة كاملة. توجد شهادة بذلك، إذ يقول الإنجيلي: "ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضًا غير أنهم بسبب الفريسيين لم يعترفوا، لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله" (يو ١٢: ٤٢-٤٣). مرة أخرى قال لهم المسيح: "كيف تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعض؟" (يو ٥: ٤٤). بلي، قال اليهود أنفسهم: "انظروا إنكم لا تنفعون شيئًا، هوذا العالم قد ذهب وراءه" (يو ١٢: ١٩). هكذا كانوا دائمًا محبين للسلطة...، أما بولس فأين كان حينئذ؟ قد يقول قائل أنه كان عند قدمي غمالائيل، ولم يكن له نصيب بين جموع المتآمرين ضد يسوع، لأن غمالائيل لم يظهر كإنسان طموح! إذن كيف ارتبط بولس بالجموع (المقاومة)؟ لقد شاهد التعليم ينمو ويسود، إذ صار مقبولًا على نطاق واسع. ففي حياة المسيح رافقه التلاميذ، وبعد ذلك صار معلمو اليهود مهجورين تمامًا، لذلك قام بولس ضد التعليم ليس كبقية اليهود بدافع حب السلطة وإنما بسبب الغيرة. ماذا كان الدافع لرحلته إلى دمشق؟ لقد ظن أن التعليم مؤذٍ، وكان يخشى من انتشاره في كل موضع. أما اليهود فلم يكن همهم الجموع إنما حب السلطة التي تأثرت بأعمالهم[42].]
ما كان يُحزن قلب بولس هو أن البسطاء قد تعرفوا على السيد المسيح وقبلوا إنجيله، حتى العشارين تمتعوا به، أما هو فقضى غالبية عمره يدرس الناموس، لكن في جهالة، إذ اهتم بحرفه دون غايته، لكن مراحم الله انتشلته إلى الاستنارة!
يقول الرسول: "وتفاضلت نعمة ربنا جدًا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع" [١٤]. لم تقف مراحم الله عند عدم معاقبته على تصرفاته الماضية من تجديف واضطهاد وافتراء، وإنما رفعته إلى حالة "الدخول في المسيح يسوع" ليصير فيه ابنًا لله ووارثًا له. هذا ما شعر به الرسول أمام نعمة الله المتفاضلة جدًا، والفائقة لكل رحمة، لذا يكمل، قائلًا: "صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا" [١٥]. هذه هي نعمة الله التي انتشلت أول الخطاة!
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [لا يرى أحد سجينًا قد صار في القصر ويشك في نوال الرحمة، هكذا كان حال بولس، مقدمًا نفسه مثالًا. فإنه لم يخجل من أن يدعو نفسه خاطئًا، بل بالحري يبتهج بذلك، مقدمًا الدليل الحسن على معجزة الله معه، هذا الذي حسبه أهلًا لحنوٍ فائق. هنا يدعو نفسه خاطئًا بل أول الخطاة، مع أنه في موضع آخر يؤكد "أنه من جهة البرّ الذي في الناموس بلا لوم" (في ٣: ٦) فبالنسبة للبرّ الذي هو من عمل الله، البرّ الذي يطلبه بحق، يُحسب حتى الأبرار في الناموس أنهم خطاة، "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رو ٣: ١٣). لذا حينما يتكلم عن بره يقول: "البرّ الذي في الناموس". إنه كمن يطلب ثروة فيظن في نفسه أنه غني، لكنه متى قارن نفسه بكنوز الملوك يحسب نفسه فقيرًا جدًا وأول الفقراء. هكذا أيضًا إذا قورن حتى الأبرار بالملائكة فإنهم يحسبون خطاة، وإن كان بولس الذي يعمل البرّ الذي في الناموس يُحسب أول الخطاة فأي إنسان يُدعى أنه بار؟ إنه لم يفعل ذلك ليدين حياته ويحكم عليها أنها دنسة، وإنما بمقارنة برّه ببرّ الله يظهر أنه غير مستحق شيئًا، ليس هذا فقط وإنما أراد أن يؤكد بأن الذين يتمتعون بهذا هم الخطاة[43].]
"لكنني لهذا رُحمت،
ليظهر يسوع المسيح فيَّ أنا أولًا كل أناة،
مثالًا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية" [١٦].
يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة بقوله:
[رُحم حتى لا ييأس أي خاطئ من نوال الرحمة، إنما يشعر كل أحد بتأكيد نواله عطية مشابهة. إنه تواضع متزايد، إذ يدعو نفسه أول الخطاة ومجدفًا ومضطهدًا وغير مستحق أنه يدعى رسولًا، مقدمًا نفسه مثالًا. افترض مدينة مزدحمة سكانها جميعهم أشرار، بعضهم شرهم متزايد والآخر شرهم أقل، فإن الكل يستحق الإدانة. فإن كان من بينهم إنسان يستحق عقوبة أكثر من الكل إذ فعل كل أنواع الشر، وقد أعلن الملك أنه يود العفو عن الجميع ربما لا يصدقوه مثلما لو عفى بالفعل عمن فعل الشر أكثر من الجميع. بهذا لا يطرأ أدنى شك لدي أحد.
هذا ما يقوله بولس: إن الله أراد أن يقدم تأكيدًا كاملًا للغفران عن العصاة، فاختاره كموضوع رحمة الله بكونه أول الخطاة. بنواله الرحمة يبرهن أنه لن تعود بعد توجد دينونة على غيره. إنه كمن يقول: إن كان الله يعفو هكذا فإنه لن يعاقب أحدًا. إن كنت أنا قد خلصت، فلا يشك أحد في الخلاص. لاحظ تواضع هذا الطوباوي إذ لم يقل: "ليظهر فيّ الأناة" بل "كل أناة"، وكأنه يقول: لا حاجة لظهور أناة أعظم مما تظهر في حالتي أنا، فليس عن خاطئ يحتاج إلى عفو الله وكل أناته وليس جزءًا منها مثلي![44]]
"وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يُرى،
الإله الحكيم وحده،
له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور. آمين" [١٧].
هذهالمراحم الإلهية التي رفعت معلمنا بولس الرسول من تحت العقوبة إلى مبعوث الكنيسة ورسولها، تمجد الله ملك الدهور. حقًا لقد تمجد الابن بهذا العمل الإلهي، وتمجد الآب كمدبر لهذا الخلاص. وكما يقول القديس يوحنا الذهبي: [من أجل هذه الأمور لا نمجد الابن وحده بل والآب أيضًا... يتمجد الآب بالأكثر عندما يصنع الابن أمورًا عظيمة[45].]
كيف نمجد الله ونكرمه؟ إننا لا نكرمه بكلمات التسبيح مثلما نكرمه بالعمل، خلال تقديسنا روحًا وجسدًا في ابنه يسوع المسيح بواسطة روحه القدوس. ليس فقط بتقديسنا نحن، وإنما أيضًا بالصلاة مع العمل الدائم لأجل تقديس كل إنسان روحًا وجسدًا. فإن كان الله قد تمجد في شاول الطرطوسي إذ رُحم وصار رسولًا للحق، فإنه بالحق تمجد بالأكثر بدخول الكثيرين خلاله إلى الحياة الجديدة وتمتعهم بروحه القدوس.
4. الجهاد في الخدمة
بعدما تحدث الرسول مع تلميذه عن الالتزام بالخدمة الرسولية، كدينٍ يوفيه لله الذي أحبه وأنقذه، وعلامة حب صادقة وارتباط بالوصية، فإنه يختم حديثه في هذا الأصحاح عن "الجهاد والخدمة"، إذ يقول: "هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها، حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة" [١٨].
يبدو أن البعض قد تنبأ عن القديس تيموثاوس أثناء عماده أو عند بدء خدمته والتزامه بالعمل الرعوي. لهذا إذ يقدم له الرسول الوصية الخاصة بالحب العملي الرعوي، لا يقدمها له من عنده، بل من الله نفسه الذي دعاه للخدمة. موضوع هذه الوصية هي أن يحارب روحيًا المحاربة الحسنة، أي يجاهد في الخدمة كمن هو في جيش روحي، لينقذ كل نفس من أسر الخطية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [كما أن في الجيش لا يخدم الكل بنفس الطاقة، إنما كل يعمل حسب موقعه، هكذا في الكنيسة يعمل واحد كمعلم وآخر كتلميذ وثالث كفردٍ من الشعب[46].]
ماذا يعني الرسول بالمحاربة الحسنة التي يلتزم بها القديس تيموثاوس؟
لا يكفي أن يجاهد في خدمته، وإنما يلزمه أن يجاهد حسنًا، أي يقدم الوصية كما يليق، يقدم وصية الله الممتدة في العهد القديم كما في العهد الجديد بروحٍ واحد وفكرٍ واحد. يقول القديس إكليمنضس السكندري أن ما ذكره الرسول هنا عن النبوات لا يخص القديس تيموثاوس شخصيًا، إنما هي نبوات العهد القديم عن الكرازة بالعهد الجديد. وكأن ما يفعله القديس تيموثاوس في خدمته إنما يحقق هذه النبوات الخاصة بالكرازة بالإنجيل.
إذ يتحدث الرسول عن الجهاد الروحي للخادم يربط الحياة الداخلية الخاصة بالخادم بالعمل الكرازي دون انفصال، إذ يقول له: "ولك إيمان وضمير صالح، الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضًا، الذين منهم هيمينايس والاسكندر، اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا، حتى لا يجدفا" [٢٠].
إن كان في كل وقد يوجد مقاومون للحق كما حدث في أيام موسى وهرون حيث ظهر الساحران، فإن الراعي الناصح يلزمه وهو يسند شعب الله ضد المقاومين للتعليم الصحيح ألا يفقد حياته الروحية، إنما ليكن له "إيمان وضمير صالح". يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على العبارة الرسولية السابقة هكذا:
[من أراد أن يكون معلمًا يلزمه أولًا أن يعلم نفسه. وكما أن الذي لم يكن يومًا ما جنديًا لا يقدر أن يكون قائدًا هكذا المعلم أيضًا (يلزمه أن يكون تلميذًا).] لهذا يقول في موضع آخر: "بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا مرفوضًا" (١ كو ٩: ٢٧).
يقول: "لك إيمان وضمير صالح" حتى تقدر أن تدبر لآخرين. عندما نسمع هذا لا نستخف بوصايا رؤسائنا حتى وإن كنا نحن أنفسنا معلمين، لأنه إن كان تيموثاوس الذي لا نستحق نحن جميعًا أن نُقارن به قد تقبل وصايا وكان يتعلم مع أنه كان معلمًا فكم بالحري يجب علينا نحن أن نقبل ذلك؟[47]]
ويقول الأسقف أمبروسيوس: [إنني أرغب في الجهاد والتعلم حتى أكون قادرًا على التعليم، لأنه يوجد سيد واحد (الله) الذي وحده لا يتعلم ما يعلّمه للجميع[48].]
أما وقد رفض بعض المعلمين الإيمان والضمير الصالح فقد "انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضًا". هذا أمر طبيعي، فإن الحياة الفاسدة تدفع حتى المعلمين للانحراف عن الإيمان المستقيم ويسقطوا في هرطقات وبدع، وبالتالي تنكسر بهم السفينة من جهة الإيمان. بمعنى آخر، كما تلتحم الحياة الروحية الفاضلة في المسيح بالإيمان المستقيم ليحيا الإنسان برجاء الفرح، هكذا تلتحم الحياة الفاسدة بالمباحثات الغبية البعيدة عن الإيمان المستقيم لتنكسر السفينة، ولا يجد المسيحي له ملجأ. وكأن الحياة هي وحدة واحدة متكاملة لا تنفصل فيها التقوى عن استقامة الحياة، وبالتالي عن الرجاء المفرح، كما لا ينفصل الفساد عن الانحراف الإيماني والسقوط في اليأس. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [إن كان أحد ينحرف عن الإيمان لا يكون له ثبات، فيسبح هنا وهناك حتى يفقد نفسه في الأعماق[49].]
يقدم لنا الرسول مثالين، قائلًا: "الذين منهم منهم هيمينايس والاسكندر، اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا، حتى لا يجدفا" [٢٠]. أما هيمينايس فهو المذكور في (٢ تي ٢: ١٧)، واصفًا إياه أنه قد زاغ عن الحق قائلًا إن القيامة قد حصلت، فيقلب إيمان كل قوم. قدم تعاليمه المضللة بإساءة استخدام كلمات السيد المسيح عن قيامة النفس من موت الخطية بالإيمان به، منكرًا قيامة الجسد في اليوم الأخير. أما الاسكندر فغالبًا هو المذكور في (٢ تي ٤: ١٤) "إسكندر النحاس أظهر لي شرورًا كثيرة، فليجازيه الرب حسب أعماله". هذان الرجلان رفضا صوت الله لكبرياء قلبيهما، فسقطا في الحياة الشريرة، وانحرفا عن الإيمان كثمرة هذه الحياة الفاسدة. لذا رأى الرسول بولس أن يسلمهما للشيطان ليس للانتقام منهما، وإنما لتأديبهما. ربما قصد بذلك الحكم عليهما بالقطع من شركة الكنيسة المقدسة حتى لا يُفسدا أفكار الإخوة، وفي نفس الوقت ربما بحرمانهما من الشركة يرجعان إلى الله بالتوبة. هذا ما حكم به الرسول على مرتكب الشر مع امرأة أبيه في كورنثوس، إذ يقول: "باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع، ليس افتخاركم حسنًا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟" (١ كو ٥: ٤-٦)
يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم: [لكن كيف يعلمهما الشيطان ألا يجدفا؟ هل يقدر أن يعلم غيره داك الذي لم يعلم نفسه، إذ لا يزال هو مجدفًا؟ ويجيب: إنه لا يعلمهما بل كما قيل "لكي يؤدبا"، إنه لا يقوم بعمل (التعليم) وإن كانت هذه هي النتيجة... فكما أن الجلادين وإن كانوا هم أنفسهم موسوسين بجرائم لا حصر لها يكونون سببًا في إصلاح الغير، هكذا يكون الأمر بالنسبة للشيطان[50].]
وكما يقول العلامة ترتليان: [بالتأديب يتعلما ألا يجدفا، فقد أعطى لخدام الله السلطان لتسليم الشخص للشيطان مع أن الشيطان نفسه ليس له سلطان علينا من ذاته[51].]
ويقول القديس چيروم: [كأن الشيطان جلاد يستخدمه الرب فيعني الرسول أن الخطاة يسلمون للشيطان لتأديبهم بواسطته حتى يرجعون إلى الله[52].]
يلاحظ أن الرسول يقول "لكي يؤدبا"، فهو لا يبغي العقوبة للانتقام، وإنما يطلب التأديب للإصلاح، لهذا وإن بدا قاسيًا على مرتكب الخطية مع امرأة أبيه (١ كو ٥: ٤-6) لكنه إذ قُطع هذا العضو عن الشركة المقدسة، وأظهر حزنًا شديدًا بالتوبة خشي عليه الرسول من اليأس، فأسرع يكتب إلى أهل كورنثوس قائلًا: "إن كنت أحزنكم أنا، فمن هو الذي يفرحني إلاَّ الذي أحزنته... هكذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يُبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمّكنوا له المحبة" (٢ كو ٢: 2، ٧-٨). ويوضح الرسول غاية التأديب بقوله: "لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جزمًا وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم" (٢ كو ١٣: ١٠)... ويعلن الرسول كيف لا يشتاق إلى التأديب بل الترفق، إذ يقول: "ماذا تريدون: أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟" (١ كو ٤: ٢١).


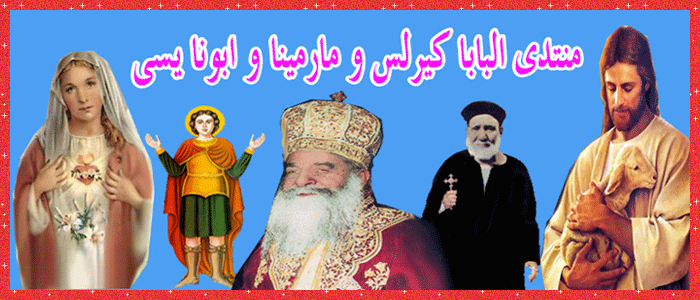











 الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف
الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف 











