قصة: أقوى من الموت!
(قصة معاصرة)
لست أقدم لك قصة شهيدٍ عاش في إحدى عصور الاستشهاد، يحتمل الآلام بفرح من أجل الإيمان بالمسيح، لكنني أروى لك ما قد لمسته بنفسي في أرض المهجر، بخصوص شاب واجه الموت عن قرب، في أحرج الظروف.
وإنني أعرض القصة لا من واقع اعترافات الشاب الخاصة ولا كسرّ عائلي إنما من خلال التفاصيل التي رواها الشاب نفسه فهزت قلوب غالبية الأقباط في المدينة التي عاش فيها.
الدموع المنسابة
فتح الشاب عينيه ليجد نفسه ملقيًا على إحدى أسرة المستشفى بلا حراك، تحاصره الآلام في كل جسده، يبذل أكثر من طبيب وممرضة كل جهدهم لتضميد جراحاته وإنقاذ حياته.
ماذا حدث؟ هكذا تساءل الشاب في داخل نفسه، لكنه لم يستطع أن يجد الإجابة كاملة في ذاكرته. وبعد تفكير عميق بدأ يتذكر تلك اللحظات الرهيبة والعصيبة حين تعرضت حياته للموت، وأدرك أنه لا طريق أمامه للنجاة. لم يكن أمامه وقت للتفكير إذ فَقَدَ وعيه للحال على أثر حادث سيارة، وها هو الآن داخل المستشفى لا يعلم هل له ساعات طويلة على هذا الحال أم أيام؟!
على أي الأحوال بدأ الشاب يفتح عينيه، فتنفس الأطباء والممرضات الصعداء، وحاولت بعض الممرضات إن يتحدثن معه بالإنجليزية في أي موضوع إلا أمر الحادث والإصابات، إذ أردن أن يبعثن روح الطمأنينة في قلبه، وحرصن أن يخرجن نفسه بعيدًا عن دائرة الألم، أما هو فلم يعطِ لأحاديثهن اهتمامًا، بالرغم مما أظهرن من حنوٍ ولطفٍ مع اهتمام شديد!
كان المصاب صامتًا تمامًا، لا يجيبهن بكلمة، ولا أبدى حتى تجاوبًا على ملامح وجهه. والأعجب من هذا أنه لم يسألهن شيئًا عن الحادث أو الإصابات التي لحقت به، كما لم يظهر شيئًا من القلق على حياته. لم يسألهن أيضًا عن زوجته وطفلتيه الصغيرتين، هذه الأسرة المتغربة عن وطنها وأهلها وعشيرتها على بعد آلاف الأميال، والتي أهملها هذا الشاب رب الأسرة ليعيش في اللهو والترف، يطلب ملذاته الخاصة مهما كان الثمن.
لقد توقفت عينا المصاب مدة ليست بقليلة، وكأنه يرى شيئًا غير ما يدور في المستشفى، أو أستغرق في تفكير عميق سحب كل طاقاته. لكنه عاد يغمض عينيه من جديد، بينما بدأت دموعه تنساب من عينيه، وقد عجزت يداه أن تمتدا لتمسحهما. امتدت يد إحدى الممرضات تمسح دموع هذا المسكين في حنو وهدوء، إذ حسبت الممرضات الواقفات حوله أنه إذ عاد إلى وعيه بدأ يشعر بألم الإصابات الخطيرة، وأنه غير قادر أن يعبر عن آلامه بالكلمات ولا حتى بالأنين، مكتفيًا أن يترك عينيه تسجلان مرارة آلامه بلغة الدموع الصامتة. ولم تدرك هؤلاء الممرضات حقيقة الأمر، فإن الشاب وقد بدأ يعود إلى وعيه لم يشعر بآلام، بل بالعكس انسحب قلبه البسيط بعيدًا جدًا عن الحادث والإصابات والآلام ليرى يد اللَّه الحانية تربت على كتفيه، وأحسّ كأن اللَّه غير المنظور بدأ يتجلى أمامه، يفتقده بحبه ليرده إلى أحضانه.
انفتحت بصيرة الشاب الداخلية ليرى مخلصه أمامه يهتم به ويرعاه. فبدأ يناجيه قائلا: "كان يمكن أن تنتهي حياتي فجأة على أثر هذا الحادث كما يحدث مع كثيرين. لكنك تحبني! أعطيتني فرصة جديدة لأعود إليك بالتوبة. وتكون أنت هو نصيبي".
حقًا لقد صغرت الدنيا جدًا في عينيْ المصاب، وأدرك أن كل ما بذله من جهد لملذاته الخاصة قد تبخر في لحظات! شعر كأن شهوات جسده قد خدعته والملذات قد ضحكت عليه. لكن هوذا السماء تنفتح الآن أمام عينيه ليرى خطة اللَّه واضحة لأجل خلاصه. شعر كأن اللَّه قد ترك كل شئ ليهتم بخلاصه هذا الذي "يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون".
انفتحت أبواب الأبدية أمامه، فنسي آلام جسده، بل تحولت تجربته إلى ألم التوبة الذي يثمر سلامًا وفرحًا، انطلق قلبه إلى ما فوق حدود الجسد وعبر فوق الزمن، فلم يفكر في مدى خطورة الإصابات ولا انشغل بمصير زوجته وطفليه إن رحل وتركهم في بلد غريب.
على أي الأحوال، انسحب قلب الشاب تمامًا عن جسده المصاب، وانطلق خارج المستشفى، وسبح في أعالي السموات، يعلن توبته الممتزجة بالشكر والتسبيح للَّه... مع أن لسانه كان صامتًا!
انتهت الفترة الحرجة وزال الخطر، وقد ساهم سلامه الداخلي في سرعة تضميد جراحاته، وتماثل جسده للشفاء، حتى أُعطى له التصريح بالرجوع إلى منزله.
استقبلته هذه العائلة الصغيرة بفرح شديد، فقد عاد إليهم من فقدوه زمانًا بسبب الضعف البشرى واغراءات العالم، أما الآن فقد وضع في قلبه ألا يعيش إلا للرب، وأن يبذل كل جهده لرعاية أسرته في الرب. عاد إليهم بجسد يحمل الكثير من الجراحات والآلام، كما يحمل روحًا حية متهللة! لقد كانت بداية حياة جديدة للعائلة كلها!
حقًا لم يكن قد شُفى الشاب من جراحاته تمامًا بل كان يتردد بين الحين والآخر على المستشفى للرعاية الطبية. هذا كله لم يفسد سلام الأسرة، ولا أفقدها فرحها بالجو الجديد الذي يعيشون فيه معًا.
---------------------------------------------------------------------------
صراحة طبيب
فجأة شعر الشاب بآلام مبرحة في معدته وأسرع إلى المستشفى يطلب طبيبه المعالج إذ حسبها من آثار الحادث.
في المستشفى عملت له الفحوص والتحليلات الطبية اللازمة. عندئذ أكد له الطبيب ضرورة إجراء عملية سريعة لاستئصال أورام ظهرت في معدته.
لا أدرى ماذا كان رد الفعل على نفس زوجته، فكلنا يعلم كيف يخاف المصريون من الأورام، ويرتبكون جدًا لمجرد تصور وجودها. هذا ما يحدث في مصر، فماذا يكون الأمر حين يكون المصري في أرض المهجر، حيث تساوره المخاوف. فليس من جو عائلي يعطى طمأنينة للإنسان، ولا من أصدقاء يلتفون حوله في مرضه.
أما عن الشاب فوافق على إجراء العملية دون أن يسأل عن مدى خطورتها، ولا حتى أظهر شيئًا من الارتباك. وبالفعل تحدد اليوم، وأُجريت العملية بسرعة فائقة. لم تمضِ إلا وقت قليل ليجد الشاب نفسه قد عاد إلى وعيه، والطبيب أمامه يتحدث معه في صراحة كاملة، قائلا له:
"كنا نظن أننا سنستأصل الأورام التي في معدتك، لكننا فوجئنا بالأورام منتشرة في كل بطنك، فلم نقدر أن نستأصل شيئًا.
إنني أتحدث معك في صراحة، أنه لا علاج لك هنا، ولا في أي بقعة في العالم، فقد لحق مرض السرطان بكل أحشائك. كل ما نقدمه لك هو مجموعة من الحقن من المسكنات أو المخدرات لتخفيف آلام المرض.
إنها أسابيع قليلة couple of weeks، بعدها تجتاز آلام مرة لا تحتمل. ثم تدخل في غيبوبة، على أثرها تنتهي حياتك.
لهذا فإني أنصحك أن تغادر المستشفى، لكي تدبر أمور الوصية مع محاميك، حتى تطمئن على مستقبل زوجتك وطفليك قبل موتك".
هكذا كان الطبيب صريحًا جدًا، إذ أدرك بخبرته الطبية أن وقت رحيل الشاب قد اقترب، وعليه أن يواجه الواقع مهما يكن الثمن.
عاد فتحدث الطبيب مع زوجة الشاب أيضًا في صراحة كاملة، طالبًا منها ألا تعالج الأمر بالعاطفة بل بالتفكير الجاد، فإنه لم يعد هناك وقت للعواطف. لم يكن الأمر سهلًا على مثل هذه الزوجة أن تسمع هذا الخبر، لكنها أمام الظروف المحيطة بها كان لابد لها أن تتمالك نفسها ولو قليلًا حتى تدبر الأمر مع زوجها. سمح لها الطبيب أن تأخذ من المستشفى مجموعة من "الحقن" لتسكين الألم، لاستخدامها أثناء وجود زوجها في البيت كلما اشتدت به الآلام حتى يعود إلى المستشفى من جديد.
خرج الزوج هذه المرة من المستشفى قبل أن يلتئم جرح العملية، ترافقه زوجته المسكينة ترى شبح الموت يهاجم رجلها الشاب ليحطم الأسرة تمامًا!
-----------------------------------------------------------------------
أقوى من الموت!
في ظهيرة أحد الأيام جاءني شماس في حالة ارتباك شديد، وإذ سألته عن سبب ارتباكه أجابني في مرارة:
"لي زميل في العمل، قبطي، لا تعرفه إذ لم يدخل الكنيسة منذ سنوات طويلة من قبل مجيئك إلى هنا، ولا يوجد عنوانه بالكنيسة، إذ له ظروف خاصة، وهو يقطن بعيدًا قليلًا عن الكنيسة. أعرفه جيدًا، فهو شاب لطيف ومحب للغاية، كله مرح وحيوية. عرف بصراحته الزائدة حتى أنه لم يترك زميلًا، أيا كانت جنسيته، إلا ويروى له دقائق تصرفاته. لقد انحرف في حياة اللهو علنًا أمام زملائه، لكنه إذ أصيب بحادث سيارة كادت تنهى حياته قدم توبة صادقة. وفى أثناء علاجه بعد عودته إلى منزله أدرك الأطباء أنه مصاب بداء السرطان. حاولوا استئصال الأورام السرطانية لكنهم فوجئوا بالمرض قد تغلغل في كل بطنه، وقد صارحه الطبيب أن يدبر أمور عائلته المالية لأن أيام رحيله قد قربت... وها هو في البيت يطلبك".
روى لي الشماس هذه القصة، وإن كان في شيء أكثر من التفاصيل، والآلام تمزق نفسه في الداخل. أحسست بصدق كيف كان هذا الشماس يتكلم بحبٍ، وكأنما المصاب أخوه شقيقه، والعائلة المسكينة من أهله المقربين إليه جدًا.
ما أن سمعت الحديث حتى ملأت المرارة نفسي تمامًا، أشعر بمسئولية الكنيسة أمام مثل هذا الإنسان، حتى وإن لم يترك عنوانه بها، فقد كان عليها أن تبحث عن كل نفسٍ أتعبتها الخطية وسحبها العالم. تخيلت ماذا كان الموقف لو انتهت حياة هذا الشاب في الحادث؟ وممن يطلب دمه؟!
هذا من جانب، ومن جانب آخر وضعت في قلبي أن أسرع إلى هذه العائلة، لإنقاذ نفس هذا الشاب، ومساندته حتى النفس الأخير، والاهتمام بالعائلة روحيًا ونفسانيًا...
لم تمضِ إلا دقائق حتى كنت مع الشماس متجهين إلى بيت هذه الأسرة، لا أفكر ماذا أقول لشابٍ غريبٍ يواجه الموت وعائلة متغربة تنتظر رحيل عائلها، إنما كنت أعلم أن اللَّه محب البشر هو وحده الذي يقدر أن يسند أولاده ويقويهم في أشد لحظات الضيق.
بعد أقل من ساعة كنت أقرع الباب، وإذا بسيدة طيبة تفتح الباب في هدوء عجيب مع بساطة، وهى تقول لي "صلِ يا أبانا من أجل (فلان) لكي يشفيه الرب".
إذ طيبت خاطرها بكلمة بسيطة دخلت مع الشماس إلى حيث يرقد زوجها. لقد كان مستلقيًا على سريره بلا حراك، لكنه في حيوية عجيبة رفع رأسه وتعانقنا! كانت البشاشة قد انطبعت على ملامح وجهه، والفرح يملأ قلبه، فقد ابتهج بدخولنا، كأن السماء قد انفتحت أمامه. وأنا في داخلي كنت أتساءل: "هل هذا حال شاب يواجه موتًا أكيدًا، ويعرف أن رحيله قد اقترب جدًا، وليس من يتحمل المسئولية من بعده نحو زوجته وطفليه الغرباء؟"
ما أبعد هذا المنظر عما اعتدت أن أراه في أرض المهجر، فإن كثيرين في حالة اضطراب، يخافون المرض أو الموت، ويرتبكون لأبسط الأسباب، إذا يشعرون بالذنب نحو أولادهم الذين أتوا بهم من وسط عائلاتهم إلى أرض غريبة وبعيدة.
على أي الأحوال، رحب الشاب بقلبه وملامحه بي أكثر مما بلسانه، وطلبت من الكل مغادرة الحجرة لنبقى معًا ليعترف.
لا أستطيع أن أتحدث عما دار في تلك اللحظات الخالدة التي كنت أشعر فيها بحق أن روح اللَّه القدوس كان يرافقنا بل يضمنا، وكأن السماء قد انفتحت والسمائيين يتهللون فرحًا!
قدم الشاب توبة صادقة بعد سنوات طويلة، وامتزجت دموعه بفرحه الروحي مع سلام عميق. أما عن اعترافاته فليس من حقي أن انطق بكلمة واحدة منها حتى بعد رحيله. إنما أقول كانت نفسي في داخلي تهتز مع كل كلمة ينطقها وكل تنهد يصدر من أعماقه. انسحقت مع انسحاق قلبه، كما فرحت وتهللت لفرحه وبهجته.
بعد الاعتراف عاد الشماس إلى الحجرة وأيضًا زوجة الشاب، ودار الحديث كله حول كلمة الإنجيل والتسبيح وحياة الشكر، كما كانت الأبدية هي مركز تأملاتنا معًا. طلب الشاب مجموعة من التسجيلات الخاصة بالقداسات الإلهية والتسابيح، حتى يقضى وقته وهو على السرير مشغولًا بمخلصه، كما طلب أن يتناول من الأسرار المقدسة.
أحضرت له "الأسرار المقدسة" أكثر من مرة وكنت أزوره، وكثير من الأقباط كانوا يقدمون إلى بيته ليروا الشاب الذي يواجه الموت المؤكد بفرح وسرور!
أقول بصدق أنه في كل زياراتي التي قمت بها إليه في أيامه الأخيرة لم أره قط عابسًا ولا مكتئبًا، بالرغم مما يعرف عن شدة آلام السرطان. لم أره قط متذمرًا بل كان كثير من المتألمين يقدمون إلى بيته ويخرجون وقد ملأ السلام قلوبهم.
كانت أحاديثه مع زائريه تدور حول رعاية اللَّه له وحبه، وحول الأبدية التي يجرى نحوها وينتظرها.
كثيرًا ما كان يردد هذه العبارات التي أتذكرها تمامًا: "صلِ يا أبانا من أجلى، لا لكي أُشفى، فأنا لا أخاف الموت، بل أشكر الذي هيأني للتمتع بالأبدية، لكنني أطلب ألا أدخل في الآلام المرة التي قال عنها الطبيب، لئلا بسبب ضعفى أخطئ، ولو بالفكر أو في قلبي، في حق اللَّه.
أنا لا أطلب من اللَّه أن يطيل عمري من أجل الطفلتين، فهما ملك اللَّه، وهو الملتزم برعايتهما".
مضت حوالي ثلاثة أسابيع ولم يدخل بعد الشاب في الآلام التي أخبره عنها الطبيب، لكن فجأة اتصلت زوجته تليفونيًا بالكنيسة لتخبر أن زوجها قد دخل في غيبوبة، وصار في خطر، وأنها تطلب الإسعاف لتحمله إلى المستشفى. وإذ علمت بالخبر في ساعة متأخرة من الليل ذهبت إلى المستشفى لكن هيئة التمريض أخبرتني أن زوجته قد عادت إلى بيتها، ليس معه أحد من أصدقائه. انه منذ دخل في الغيبوبة لم يتكلم مع أحدٍ. وها هو في أنفاسه الأخيرة.
دخلت حجرته لأراه بين الأجهزة وحيدًا، اللَّهم إلا من رعاية إحدى الممرضات.
وقفت أمام هذا الملاك الذي حمل الآلام بفرح وانتظر تلك الساعة ببهجة قلب. صليت ثم ناديته بصوت خافت جدًا، ففتح عينيه، لسانه عجز عن أن يتكلم، ابتسم قليلًا ليغمض عينيه الجسديتين، وبعد دقائق أسلم الروح!


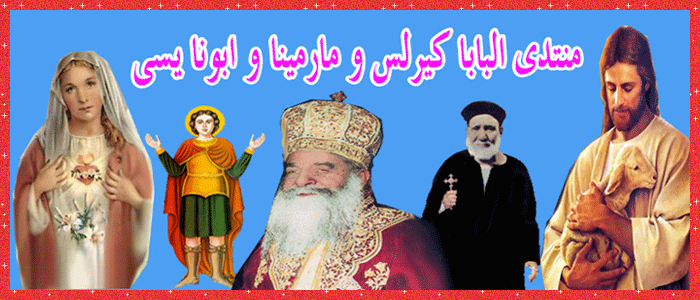











 الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف
الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف 











