
لوقا 14 - تفسير إنجيل لوقا
التوبة العملية الجزء(1) للقمص تادرس يعقوب ملطي
إذ حدثنا عن التوبة كطريقٍ، بدونه لن نلتقي مع صديقنا السماوي، فإن هذه التوبة يجب أن تترجم عمليًا في الآتي:
1. السمو فوق الحرف
1-6.
2. عدم اشتهاء المتكآت الأولى
7-11.
3. اتساع القلب للمحتاجين
12-14.
4. الاهتمام بالدعوة للوليمة
15-24.
5. حمل الصليب
25-35.
أولًا: مثال بناء البرج
ثانيًا: مثال الملك الذي يحارب
1. السمو فوق الحرف
"وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين في السبت ليأكل خبزًا،
كانوا يراقبونه.
وإذا إنسان كان مستسقٍ كان قدامه.
فأجاب يسوع وكلّم الناموسيين والفرِّيسيِّين، قائلًا:
هل يحل الإبراء في السبت؟
فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه.
ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر
ولا ينشله حالًا في يوم السبت؟!
فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك" [1-6].
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي فيها يقبل السيِّد المسيح الدعوة ليأكل في بيت فرِّيسي أو أحد رؤساء الفرِّيسيِّين، ولعل قبوله دعوتهم له كان أحد ملامح كرازته التي تقوم أولًا على علاقات الصداقة والحب. فإنه ما جاء لينافسهم على كراسيهم، بل ليفتح قلبه بالحب لهم كما لغيرهم ليكسبهم في ملكوته أحبَّاء وأصدقاء على مستوى أبدي.
يروي لنا الإنجيلي لوقا قبوله دعوة سمعان الفريسي (7: 36-50) حيث التقى هناك بالمرأة الخاطئة التي قدَّمت بدموعها وحبها وليمة فائقة، فاقتنت غفران خطاياها الكثيرة. كما قبل دعوة فرِّيسي آخر حيث كشف له السيِّد مفهوم التطهير الداخلي والنقاوة القلبية عوض الاهتمام بالغسالات الجسديَّة وحدها (11: 37 الخ.). والآن للمرة الثالثة يقبل الدعوة ليأكل خبزًا في بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين ليكشف له عن المفهوم الحقيقي للسبت. في الدعوة الأولى يدعو السيِّد المسيح الفرِّيسيِّين للتوبة خلال الحب، وفي الثانية يطلب نقاوتهم الداخليَّة، وفي ثالثة يطلب العبادة الروحيَّة.
لقد دعاه الفرِّيسي وكان مع زملائه الفرِّيسيِّين "يراقبونه" [1]؛ يريدون أن يصطادوا له أخطاء عوض الانتفاع بصداقته.
يقول القديس كيرلس الكبير:
[دعا فرِّيسي ذو رتبة عاليَّة يسوع إلى وليمة؛ ومع معرفة السيِّد لمكر الفرِّيسيِّين ذهب معه وأكل وهو في صحبتهم. تنازل وقبل ذلك لا ليكرم من دعاه، وإنما ليفيد من هم في صحبته بكلماته وأعماله المعجزية، لكي يقودهم إلى معرفة الخدمة الحقيقيَّة، ولكي يعلمنا نحن أيضًا ذلك في إنجيله. لقد عرف أنه سيجعلهم شهود عيان - بغير إرادتهم - لسلطانه ومجده الفائق للمجد البشري، لعلهم يؤمنون به أنه الله وابن الله، الذي أخذ بالحق شبهنا دون أن يتغير أو يتحول عما هو عليه. صار ضيفًا للذين دعوه، لكي يتمم عملًا ضروريًا كما قلت، أما هم فكانوا يراقبونه، ليروا أن كان يستهين بالكرامة اللائقة بالناموس فيمارس عملًا أو آخر محرمًا في السبت.
أيها اليهودي فاقد الإحساس، لتفهم أن الناموس كان ظلًا ورمزًا ينتظر الحق، وأن الحق هو المسيح ووصاياه. فلماذا تتسلَّح بالرمز ضد الحق؟ لماذا تقيم الظل مضادًا للتفسير الروحي؟ احفظ سبتك بتعقل، فإن كنت غير مقتنع بفعل هذا، فإنك تنزع عن السبت الأمور التي ترضي الله، وتكون غير مدرك للراحة (السبت) الحقيقيَّة، التي يطلبها الله منا، والتي تحدَّث عنها قديمًا في ناموس موسى. لنكف عن الخطايا، ولنسترح بترك المعاصي، ولنغتسل من الأدناس، ولنترك محبَّة الجسد الشهوانية، ولنهرب من الطمع والنهب ومن الربح القبيح ومحبَّة المال الحرام. لنجمع أولًا مئونة لنفوسنا تسندنا في الطريق، الطعام الذي يكفينا في العالم العتيد، ولنلجأ للأعمال المقدَّسة، فنحفظ السبت بطريقة عاقلة.
الذين يمارسون الخدمة بينكم اعتادوا أن يقدَّموا لله الذبائح المعينة في السبت، يذبحون الذبائح في الهيكل، ويتممون أعمال الخدمة الموكل بها إليهم ومع ذلك لم ينتهرهم أحد، بل والناموس نفسه صمت! إذن، الناموس لم يمنع البشر من الخدمة في السبت.
هذا كان رمزًا لنا، وكما قلت، أنه من واجبنا أن نحفظ السبت بطريقة عقليَّة، فنُسّر الله بالرائحة الذكيَّة الروحيَّة. وكما قلت قبلًا، نحقَّق هذا عندما نكف عن الخطايا، ونقدَّم لله تقدَّمة مقدَّسة، حياة مقدَّسة تستحق الإعجاب، متقدَّمين بثبات في كل الفضيلة. هذه هي الذبيحة الروحيَّة التي تسر الله.
إن لم يكن لك هذا في ذهنك، فإنك إنما تلتصق بغلاظة القلب التي ذكرها الكتاب المقدَّس، تاركًا الحق كأمرٍ لا تقدر أن تقتنيه، منصتًا لقول الله الذي يخبرك بصوت إشعياء النبي: "غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، وأطمس عينيه، لئلاَّ يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه، ويرجع فيُشفى" (إش 6: 10)...
ماذا كانت المعجزة التي كانوا يراقبونها؟
كان يوجد قدامه إنسان مستسقٍ، فسأل الرب الناموسيين والفرِّيسيِّين أن كان يحل الإبراء في السبت أم لا؟ فسكتوا...
لماذا سكت أيها الناموسي؟ اقتبس شيئًا من الكتاب المقدَّس، لتظهر أن ناموس موسى يمنع عمل الخير في السبت. برهن لنا أنه (الله) يريدنا قساة القلب بلا رحمة، من أجل راحة أجسادنا، وأن يمنع اللطف من أجل تكريم السبت. هذا ما لا تستطيع برهانه من أي جزء في الكتاب المقدَّس.
إذ سكتوا بسبب المكر، فنّد المسيح عارهم الذي لا يحل، مقدَّما لهم البراهين.
يقول: "من منكم يسقط ابنه (في بعض النسخ ابنه والأخرى حماره) أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالًا في يوم السبت؟!" [5] إن كان الناموس يمنع إظهار الرحمة في السبت، فلماذا تمارسون الشفقة على الساقط في حفرة؟ لا ترتبك بالخطر الذي يحيق بابنك في السبت، بل انتهر العاطفة الطبيعيَّة التي تحثك بالحب الأبوي! لتدفع بابنك إلى القبر وأنت مبتهج، لكي تكرم واهب الناموس. كما لو كان قاسيًا غير رحيم! اترك صديقك في خطر، ولا تعطه أي اهتمام، بل وإن سمعت بكاء طفل صغير يطلب العون قل له: لتمت، فإن هذه هي إرادة الناموس!
إنك لا تقبل هذا، بل تبسط يديك للمتضايق، معطيًا إيَّاه اهتمامًا أكثر من تكريمك للناموس، أو للراحة (السبت) التي بلا أحاسيس، حتى وإن كنت لم تعرف بعد أن السبت يلزم أن يُحفظ بطريقة روحيَّة.
إله الجميع لا يكف عن أن يترفق، فهو صالح ومحب للبشر، لم يؤسس ناموس موسى لتحقيق الغلاظة، ولا أقامه كمعلم للقسوة، بل بالحري ليقودك لمحبَّة قريبك...
إذ لم يعط اهتمامًا لحسد اليهود خلّص الرجل من مرضه أي الاستسقاء[571].]
على أي الأحوال إن كان اليهودي حتى في حرفيته للناموس إن رأى حماره أو ثوره ساقطًا في حفرة لا يستطيع أن يقف جامدًا بل يتعدى الحرف لينقذ الحيوان من الخطر، أفليس بالأولى الله كلي الحب والرحمة إذ رأى البشريَّة وقد صارت شعبين، اليهود الذين تثقّلوا بنير الحرف القاتل فصاروا كالثور في حفرة الهلاك، والأمم قد امتلئوا غباوة خلال العبادة الوثنية فصاروا كالحمار الذي بلا فهم... أفلا يهتم الله بخلاصهم ليهبهم سبتًا حقيقيًا، وراحة على مستوى أبدي؟!
هذا ويرى القديس أغسطينوس أن المريض بالاستسقاء كلما شرب ماءً يزداد عطشًا، لأن الماء يُفرز عن الدم، هكذا مُحب الغنى كلما نال من البركات الزمنيَّة زاد عطشه إليها بلا شبع إذ يقول: [بحق يقارن المريض بالاستسقاء بالغني الطمّاع. الأول كلما نال رطوبة غير طبيعيَّة زاد عطشه هكذا الغني الطامع نال غنى بفيض يسيء استخدامه فيزداد شغفًا لمحبَّة الغنى[572].]
يقدَّم لنا الإنجيلي إبراء هذا المريض بالاستسقاء، قائلًا: "فأمسكه وأبرأه وأطلقه" [4]. إنها ثلاث مراحل يجتازها الإنسان لينعم بعمل السيِّد المسيح الخلاصي، وهي:
أ. أمسكه: إن كان المرض قد أمسك بحياتنا، فنحن نحتاج إلى كلمة الله، الطبيب الحقيقي الذي نزل إلينا لكي يمسك بنا، فنكون في حوزته، نقبل الالتصاق به والدخول إلى الشركة معه. يمسكنا الرب بكشفه عن أسرار حبه خلال الصليب، فيأسر حياتنا ويمتص كل مشاعرنا وأحاسيسنا لحسابه كما قدَّم حبه لنا، فنقول: "حبيبي لي وأنا له" (نش 2: 16).
ب. أبرأه: إذ يمسك بنا ونحن به، ننعم بخلاصه فنبرأ من خطايانا... بمعنى آخر لقاؤنا معه يقوم على الصراحة الكاملة، نعترف له بخطايانا لننهل بالمغفرة ونتمتع بأعمال محبَّته الخلاصيَّة بلا انقطاع.
ج. أطلقه: غاية الالتقاء مع المخلِّص أن نتمتع بانطلاقة الحريَّة كأولاد الله، لكي نوجد على الدوام ثابتين فيه، ونحسب ورثة الله أبينا ووارثون مع المسيح (رو 8: 17).
هذا هو عمل السيِّد المسيح فينا: نلتقي به مُمسكين بمحبَّته، نبرأ به من خطايانا، نتحرَّر كأولاد الله لنوجد فيه أبديًا.
2. عدم اشتهاء المتكآت الأولى
إذ أراد لنا السيِّد المسيح أن نقبل صداقته لنا سألنا أن نرتفع فوق الحرف، فلا نحفظ السبت بطريقة ماديَّة جافة، وإنما بطريقة روحيَّة لننعم بالراحة الأبديَّة، بإبرائنا لا من مرض الاستسقاء بل من كل خطيَّة، وتحريرنا لنوجد معه أبديًا، هذا ما رأيناه في العبارات السابقة، أما الآن فكصديقٍ لنا يريدنا أن نحمل سماته فينا حتى نقدر أن نلتقي معه، ولعل أهم هذه السمات هي التواضع وعدم محبَّة المتكآت الأولى. إنه لا يدعونا لعدم اشتهاء هذا الموضع لإذلالنا ولا ليقلل من كرامتنا، وإنما لأنه إذ اتضع واحتل المركز الأخير "كعبدٍ"، أرادنا أن نشتهي هذا المركز لنوجد معه خلال روح التواضع المملوء حبًا. بمعنى آخر سعْينا للمتكأ الأخير لا يقوم على شعور بالنقص ولا عن تغصب، وإنما عن حب حقيقي لحمل المسيح صاحب المتكأ الأخير. فيتجلَّى فينا، وتعلن سماته بقوَّة مشرقة على من حولنا، فيصير ذلك سرّ مجد داخلي في الرب.
"وقال للمدعوين مثلًا،
وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكآت الأولى، قائلًا لهم:
متى دعيت من أحد إلى عرسٍ،
فلا تتكئ في المتكأ الأول،
لعل أكرم منك يكون قد دُعي منه،
فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانًا لهذا،
حينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير"[7-9].
* ربما تبدو مثل هذه الأمور للبعض تافهة ولا تستحق إعارتها الانتباه، لكن متى ركز الإنسان عيني ذهنه عليها فسيتعلم من أي عيب تخلّص الإنسان، وأي تدبير حسن توجده فيه. فإن الجري وراء الكرامات بطريقة غير لائقة لا تناسبنا ولا تليق بنا، إذ تظهرنا أغبياء وعنفاء ومتغطرسين، نطلب لا ما يناسبنا بل ما يناسب من هم أعظم منا وأسمى.
من يفعل هذا يصير كرهًا، غالبًا ما يكون موضع سخريَّة عندما يضطر بغير إرادته أن يرد للآخرين الكرامة التي ليست له... يلزمه أن يعيد ما قد أخذه بغير حق.
أما الإنسان الوديع والمستحق للمديح الذي بدون خوف من اللوم يستحق الجلوس بين الأولين لكنه لا يطلب ذلك لنفسه بل يترك للآخرين ما يليق به، فيُحسب غالبًا للمجد الباطل وسيتقبل مثل هذه الكرامة التي تناسبه، إذ يسمع القائل له: "ارتفع إلى فوق" [10].
إذن العقل المتضع عظيم وفائق الصلاح، يخّلص صاحبه من اللوم والتوبيخ ومن طلب المجد الباطل…
إن طلبت هذا المجد البشري الزائل تضل عن طريق الحق الذي به يمكنك أن تكون بالحق مشهورًا وتنال كرامة تستحق المنافس! فقد كُتب: "لأن كل جسد كعشبٍ، وكل مجد إنسان كزهر عشب" (1 بط 1: 24). كما يلوم النبي داود محبي الكرامات الزمنيَّة، قائلًا لهم هكذا: "ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يُقلع" (مز 129: 6). فكما أن العشب الذي ينبت على السطح ليس له جذر عميق ثابت لذا يجف سريعًا، هكذا من يهتم بالكرامات الدنيويَّة بعد أن يصير ظاهرًا في وقت قصير كالزهرة يسقط إلى النهاية، ويصير كلا شيء.
إن أراد أحد أن يسبق الآخرين فلينل ذلك بقانون السماء، وليتكلل بالكرامات التي يهبها الله. ليسمو على الكثيرين بشهادة الفضائل المجيدة، غير أن قانون الفضيلة هو الذهن المتواضع الذي لا يطلب الكبرياء بل التواضع! هذا هو ما حسبه الطوباوي بولس أفضل من كل شيء، إذ كتب إلى أولئك الذين يرغبون في السلوك بقداسة: احبوا التواضع (كو 3: 12). وقد مدح تلميذ المسيح ذلك، إذ كتب هكذا: "ليفتخر الأخ المتضع (المسكين) بارتفاعه، وأما الغني فبتواضعه لأنه كزهر العشب يزول" (يع 1: 9-10). الذهن المتضع والمنضبط يرفعه الله، إذ "القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره" (مز 51: 17).
من يظن في نفسه أمرًا عظيمًا وساميًا فيتشامخ في فكره وينتفخ في علو فارغ يكون مرذولًا وتحت اللعنة، إذ يسلك على خلاف المسيح القائل: "تعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب" (مت 11: 29). كما قيل: "لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (1 بط 5: 5). لقد أظهر الحكيم سليمان في مواضع كثيرة الأمان الذي يحل بالذهن المتضع، إذ يقول: "لا تنتفخ كي لا تسقط" (ابن سيراخ 1: 30)؛ كما يعلن ذات الأمر بطريقة تشبيهية: "المعلي بابه (بيته) يطلب الكسر" (أم 17: 19). مثل هذا يبغضه الله بعدل إذ يُخطئ في حق نفسه ويود أن يتعدى حدود طبيعته بغير شعور…
أسألك، على أي أساس يظن الإنسان في نفسه أمرًا عظيمًا...؟!
ليت كل إنسان ينظر إلى حاله بعينين حكيمتين فيصير كإبراهيم الذي لم يُخطئ في إدراك طبيعته بل دعي نفسه ترابًا ورمادًا (تك 18: 27)[573].
القديس كيرلس الكبير
* هل ترفض أن تتواضع وأنت بالفعل ساقط؟! شتان ما بين من يتضع ومن هو بالفعل ساقط على الأرض. أنت مُلقى على الأرض، أفلا تريد أن تتواضع؟![574]
القديس أغسطينوس
* لا يحصل طالب الكرامة على ما يطمع فيه إنما يعاني من خيبة أمل، وإذ يشغل نفسه بكيفيَّة تثقله بكرامات إذا بها يجد إهانات. وإذ لا يوجد شيء أفضل من التواضع لذلك يقود السيِّد السامع له لا إلى رفض طلب الأماكن المرموقة، وإنما يوصيه بالبحث عن الأماكن المتضعة[575].
القديس يوحنا الذهبي الفم
* لا يظن أحد في وصايا المسيح هذه أنها تجعله شخصًا تافهًا غير مستحق لسمو كلمة الله وجلالها.
الأب ثيؤفلاكتيوس
هذا ويحذِّرنا القديس باسيليوس من إساءة فهم كلمات السيِّد المسيح، فإنه طلب منا ألا نشتهي المراكز الأولى بل نطلب المتكأ الأخير، لكننا نطلبه بهدوء وفي تواضع ونظام لا خلال العنف أو حب الظهور، فإن سألنا صاحب الدعوة أن نأخذ المتكأ الأول نقبل بهدوء أيضًا ولا نفسد نظامه... بمعنى آخر أن كلمات السيِّد تمس أعماق القلب لكي لا يشتهي الإنسان المجد الباطل، سواء جلسنا هنا أو هناك. الله يطلب القلب لا المظهر الخارجي. لذلك ختم السيِّد المثل بقوله: "لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع" [11].
يمكننا أن نقول بأن صاحب العرس أو الوليمة هو رب المجد يسوع نفسه الذي دعانا جميعًا لنتكئ في كنيسته، الوليمة المفرحة للنفس، فيجتاز في وسطها بلا توقف لأنها مقدَّسة ليرى أصحاب القلوب المتواضعة، فيفيض عليهم من ثمر روحه القدُّوس بغنى، ويرفعهم في أعين السمائيين والأرضيين، وكما قالت القدِّيسة مريم حين قبلت صاحب الوليمة في أحشائها: "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين" (لو 1: 52).
3. اتساع القلب للمحتاجين
إذ قدَّم لنا السيِّد بتواضعه أساسًا بقبول صداقته أن نحمل فينا فكره، فنسلك بروح التواضع طالبين المتكأ الأخير، مشتهين ترك المتكآت الأولى لإخوتنا، مقدَّمين بعضنا البعض في الكرامة (رو 12: 10)، الآن يسألنا أيضًا أن نتمثل به بكونه صديقنا السماوي فنحمل قلبًا متسعًا للمحتاجين والمعوزين والمعوقين والمطرودين. إن كان الرب في تجسده قد جاء إلى الإنسان الضائع تاركًا خليقته السماويَّة، أي التسعة والتسعين حَمَلًا ليطلب الخروف الضال، محتملًا بالحب آلام الصليب ليرفعه علي منكبيه ويحمله إلى مجد سماواته، هكذا يليق بنا أن نبحث عن كل محتاج وذليل.
"وقال أيضًا للذي دعاه:
إذا صنعت غذاءً أو عشاءً فلا تدع أصدقاءك
ولا أخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء،
لئلاَّ يدعوك هم أيضًا فتكون لك مكافأة.
بل إذا صنعت ضيافة، فادع المساكين الجدع العرج العُمي.
فيكون لك الطوبى،
إذ ليس لهم حتى يكافؤك،
لأنك تكافئ في قيامة الأبرار" [12-14].
* إن كنا نخجل من هؤلاء الذين لا يخجل منهم المسيح، فنحن نخجل من المسيح نفسه بخجلنا من أصدقائه. لتملأ مائدتك من العرج والمشوهين، فإن المسيح يأتيك خلالهم لا خلال الأغنياء[576].
* إن دعوت صديقًا يبقى يشكرك حتى المساء، لكن الصداقة تبقى إلى حين وتنتهي سريعًا جدّا فلا توازي ما تكلفته من مصاريف. أما أن دعوت فقيرًا أو مشوهًا، فإن الشكر لا يفسد، لأن الله يذكره لك أبديًا، لن ينساه، إذ يكون هو نفسه مدينًا لك[577].
* لنتبع الصداقات التي حسب الروح لأنها قويَّة ويصعب حلها، وليس الصداقات التي تقوم حول المائدة[578].
* كلما كان أخونا متواضعًا يأتي المسيح خلاله ويفتقدنا. لأن من يستضيف إنسانًا عظيمًا غالبًا ما يفعل هذا عن مجدٍ باطلٍ... ليتنا لا نطلب القادرين أن يكافؤننا، بل نتبع القول: "فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافؤك".
ليتنا لا نضطرب حينما لا يُرد لنا اللطف باللطف، لأننا إن تقبلناه من الناس لا ننال ما هو أكثر، أما إذا لم يُرد لنا من البشر فالله يرده لنا.
* يليق بك أن تستقبل (الفقراء) في أفضل حجراتك، فإن أحجمت عن هذا فلا أقل من أن تتقبل المسيح في الحجرات الدنيا حيث يوجد الذين يقومون لك بالأعمال الحقيرة والخدم.
ليكن الفقير علي الأقل حافظًا بابك، لأنه حيث توجد الصدقة لا يقدر الشيطان أن يقتحمه ويدخل.
إن لم تجلس معهم، فعلى الأقل ارسل لهم الأطباق من مائدتك[579].
القديس يوحنا الذهبي الفم
يستعرض القديس كيرلس الكبير[580] تعليقاته علي هذا المثل قائلًا بأن المهتمين بتقديم صور جميلة لا يكتفون باستخدام لون واحد، هكذا إله الجميع واهب الجمال الروحي ومعلمه يزين نفوسنا بفضائل متنوعة لنحمل حياة مقدَّسة من جوانب متنوعة [ليكمل فينا شبهه.] لهذا أمر السيِّد المسيح الناموسيين والفرِّيسيِّين والكتبة أن يسلكوا بروح التواضع ويتحرَّروا من محبَّة المجد الباطل وألا يطلبوا المتكآت الأولى، والآن يطلب منهم محبَّة الفقراء، فلا يستضيفوا في ولائمهم الأغنياء لطلب المديح وحب الظهور بل المحتاجين والمعوقين والمتألَّمين بكل أنواع الأمراض الجسديَّة للحصول علي الرجاء في العلويَّات من الله نفسه. يكمل القديس كيرلس الكبير حديثه عن هذه الفضيلة التي تزين النفس، قائلًا:
[الدرس الذي يعلمنا إيَّاه هو حب الفقراء، الأمر الثمين في عيني الله...
هل تشعر بالسرور عندما يمدحك أصدقائك وأقاربك الذين تستضيفهم في الوليمة؟ أخبرك بما هو أفضل، فإن الملائكة تمدح سخاءك، والقوات العلويَّة العاقلة والقدِّيسون يفعلون ذلك، بل والله أيضًا يقبل هذا الذي يسمو بالكل ويحب الرحمة وحنون. اقرضه ولا تخف، فسيرده إليك ومعه ربا، إذ قيل "من يرحم الفقير يقرض الرب" (أم 19: 17). أنه يعرف القرض ويعد بالوفاء به (مت 18: 23 الخ)...
اقتن النعمة النابعة عن الله. اقتن لك رب السماء والأرض صديقًا، فإنه بالحق يقتني الإنسان صداقة البشر غالبًا بذهبٍ كثيرٍ، فإن تصالح معنا أصحاب الرتب العاليَّة نشعر بفرحٍ عظيمٍ بتقديم هدايا أكثر من طاقتنا بسبب نوالنا كرامة الالتصاق بهم، ومع هذا فإن هذه الأمور زائلة، تنتهي سريعًا تعبر كخيال الأحلام.
ألا يليق بنا أن نحسب عضويتنا في بيت الله تستحق أن نقتنيها؟ أما نحسبها أمرًا عظيمًا؟! فبالتأكيد بعد القيامة من الأموات سنقف في حضرة المسيح، وتُقدَّم المكافأة للمترفقين والرحماء، وتكون الدينونة قاسيَّة علي العنفاء الذين لم يكن لهم الحب الطبيعي... إذ قيل: "لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة" (يع 2: 13).]
أما العلامة أوريجينوس فإذ يأخذ بالتفسير الرمزي. يرى في الوليمة، المائدة الروحيَّة حيث يليق بنا نطرد عنا المجد الباطل ونستضيف الفقراء أو المساكين أي الجهلاء الذين تعوزهم الحكمة، لكي يجدوا في مائدتنا السيِّد المسيح الذي يغني الكل. ونستضيف الضعفاء الذين يقاومون الضمير الداخلي لكي يبرأوا داخليًا. كما نستضيف العرج، أي الذين ضلّوا عن السلوك في الحق لكي يجدوا الطرق المستقيمة في الرب؛ ونستضيف العُمي الذين ليس لهم بصيرة روحيَّة لإدراك الحق لكي يتمتعوا بالنور الحقيقي... هؤلاء ليس لهم ما يكافؤننا به إذ لا يجدوا ما يجيبون به علينا أمام الكرازة المملؤة حبًا!
لوقا 14 - تفسير إنجيل لوقا التوبة العملية الجزء(1) للقمص تادرس يعقوب ملطي إذ حدثنا عن التوبة كطريقٍ، بدونه لن نلتقي مع صديقنا السماوي، فإن هذه التوبة يجب أن تترجم عمليًا في الآتي: 1. السمو فوق الحرف 1-6. 2. عدم اشتهاء المتكآت الأولى 7-11. 3. اتساع القلب للمحتاجين 12-14. 4. الاهتمام بالدعوة للوليمة 15-24. 5. حمل الصليب 25-35. أولًا: مثال بناء البرج ثانيًا: مثال الملك الذي يحارب 1. السمو فوق الحرف "وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين في السبت ليأكل خبزًا، كانوا يراقبونه. وإذا إنسان كان مستسقٍ كان قدامه. فأجاب يسوع وكلّم الناموسيين والفرِّيسيِّين، قائلًا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالًا في يوم السبت؟! فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك" [1-6]. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي فيها يقبل السيِّد المسيح الدعوة ليأكل في بيت فرِّيسي أو أحد رؤساء الفرِّيسيِّين، ولعل قبوله دعوتهم له كان أحد ملامح كرازته التي تقوم أولًا على علاقات الصداقة والحب. فإنه ما جاء لينافسهم على كراسيهم، بل ليفتح قلبه بالحب لهم كما لغيرهم ليكسبهم في ملكوته أحبَّاء وأصدقاء على مستوى أبدي. يروي لنا الإنجيلي لوقا قبوله دعوة سمعان الفريسي (7: 36-50) حيث التقى هناك بالمرأة الخاطئة التي قدَّمت بدموعها وحبها وليمة فائقة، فاقتنت غفران خطاياها الكثيرة. كما قبل دعوة فرِّيسي آخر حيث كشف له السيِّد مفهوم التطهير الداخلي والنقاوة القلبية عوض الاهتمام بالغسالات الجسديَّة وحدها (11: 37 الخ.). والآن للمرة الثالثة يقبل الدعوة ليأكل خبزًا في بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين ليكشف له عن المفهوم الحقيقي للسبت. في الدعوة الأولى يدعو السيِّد المسيح الفرِّيسيِّين للتوبة خلال الحب، وفي الثانية يطلب نقاوتهم الداخليَّة، وفي ثالثة يطلب العبادة الروحيَّة. لقد دعاه الفرِّيسي وكان مع زملائه الفرِّيسيِّين "يراقبونه" [1]؛ يريدون أن يصطادوا له أخطاء عوض الانتفاع بصداقته. يقول القديس كيرلس الكبير: [دعا فرِّيسي ذو رتبة عاليَّة يسوع إلى وليمة؛ ومع معرفة السيِّد لمكر الفرِّيسيِّين ذهب معه وأكل وهو في صحبتهم. تنازل وقبل ذلك لا ليكرم من دعاه، وإنما ليفيد من هم في صحبته بكلماته وأعماله المعجزية، لكي يقودهم إلى معرفة الخدمة الحقيقيَّة، ولكي يعلمنا نحن أيضًا ذلك في إنجيله. لقد عرف أنه سيجعلهم شهود عيان - بغير إرادتهم - لسلطانه ومجده الفائق للمجد البشري، لعلهم يؤمنون به أنه الله وابن الله، الذي أخذ بالحق شبهنا دون أن يتغير أو يتحول عما هو عليه. صار ضيفًا للذين دعوه، لكي يتمم عملًا ضروريًا كما قلت، أما هم فكانوا يراقبونه، ليروا أن كان يستهين بالكرامة اللائقة بالناموس فيمارس عملًا أو آخر محرمًا في السبت. أيها اليهودي فاقد الإحساس، لتفهم أن الناموس كان ظلًا ورمزًا ينتظر الحق، وأن الحق هو المسيح ووصاياه. فلماذا تتسلَّح بالرمز ضد الحق؟ لماذا تقيم الظل مضادًا للتفسير الروحي؟ احفظ سبتك بتعقل، فإن كنت غير مقتنع بفعل هذا، فإنك تنزع عن السبت الأمور التي ترضي الله، وتكون غير مدرك للراحة (السبت) الحقيقيَّة، التي يطلبها الله منا، والتي تحدَّث عنها قديمًا في ناموس موسى. لنكف عن الخطايا، ولنسترح بترك المعاصي، ولنغتسل من الأدناس، ولنترك محبَّة الجسد الشهوانية، ولنهرب من الطمع والنهب ومن الربح القبيح ومحبَّة المال الحرام. لنجمع أولًا مئونة لنفوسنا تسندنا في الطريق، الطعام الذي يكفينا في العالم العتيد، ولنلجأ للأعمال المقدَّسة، فنحفظ السبت بطريقة عاقلة. الذين يمارسون الخدمة بينكم اعتادوا أن يقدَّموا لله الذبائح المعينة في السبت، يذبحون الذبائح في الهيكل، ويتممون أعمال الخدمة الموكل بها إليهم ومع ذلك لم ينتهرهم أحد، بل والناموس نفسه صمت! إذن، الناموس لم يمنع البشر من الخدمة في السبت. هذا كان رمزًا لنا، وكما قلت، أنه من واجبنا أن نحفظ السبت بطريقة عقليَّة، فنُسّر الله بالرائحة الذكيَّة الروحيَّة. وكما قلت قبلًا، نحقَّق هذا عندما نكف عن الخطايا، ونقدَّم لله تقدَّمة مقدَّسة، حياة مقدَّسة تستحق الإعجاب، متقدَّمين بثبات في كل الفضيلة. هذه هي الذبيحة الروحيَّة التي تسر الله. إن لم يكن لك هذا في ذهنك، فإنك إنما تلتصق بغلاظة القلب التي ذكرها الكتاب المقدَّس، تاركًا الحق كأمرٍ لا تقدر أن تقتنيه، منصتًا لقول الله الذي يخبرك بصوت إشعياء النبي: "غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، وأطمس عينيه، لئلاَّ يبصر بعينيه، ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه، ويرجع فيُشفى" (إش 6: 10)... ماذا كانت المعجزة التي كانوا يراقبونها؟ كان يوجد قدامه إنسان مستسقٍ، فسأل الرب الناموسيين والفرِّيسيِّين أن كان يحل الإبراء في السبت أم لا؟ فسكتوا... لماذا سكت أيها الناموسي؟ اقتبس شيئًا من الكتاب المقدَّس، لتظهر أن ناموس موسى يمنع عمل الخير في السبت. برهن لنا أنه (الله) يريدنا قساة القلب بلا رحمة، من أجل راحة أجسادنا، وأن يمنع اللطف من أجل تكريم السبت. هذا ما لا تستطيع برهانه من أي جزء في الكتاب المقدَّس. إذ سكتوا بسبب المكر، فنّد المسيح عارهم الذي لا يحل، مقدَّما لهم البراهين. يقول: "من منكم يسقط ابنه (في بعض النسخ ابنه والأخرى حماره) أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالًا في يوم السبت؟!" [5] إن كان الناموس يمنع إظهار الرحمة في السبت، فلماذا تمارسون الشفقة على الساقط في حفرة؟ لا ترتبك بالخطر الذي يحيق بابنك في السبت، بل انتهر العاطفة الطبيعيَّة التي تحثك بالحب الأبوي! لتدفع بابنك إلى القبر وأنت مبتهج، لكي تكرم واهب الناموس. كما لو كان قاسيًا غير رحيم! اترك صديقك في خطر، ولا تعطه أي اهتمام، بل وإن سمعت بكاء طفل صغير يطلب العون قل له: لتمت، فإن هذه هي إرادة الناموس! إنك لا تقبل هذا، بل تبسط يديك للمتضايق، معطيًا إيَّاه اهتمامًا أكثر من تكريمك للناموس، أو للراحة (السبت) التي بلا أحاسيس، حتى وإن كنت لم تعرف بعد أن السبت يلزم أن يُحفظ بطريقة روحيَّة. إله الجميع لا يكف عن أن يترفق، فهو صالح ومحب للبشر، لم يؤسس ناموس موسى لتحقيق الغلاظة، ولا أقامه كمعلم للقسوة، بل بالحري ليقودك لمحبَّة قريبك... إذ لم يعط اهتمامًا لحسد اليهود خلّص الرجل من مرضه أي الاستسقاء[571].] على أي الأحوال إن كان اليهودي حتى في حرفيته للناموس إن رأى حماره أو ثوره ساقطًا في حفرة لا يستطيع أن يقف جامدًا بل يتعدى الحرف لينقذ الحيوان من الخطر، أفليس بالأولى الله كلي الحب والرحمة إذ رأى البشريَّة وقد صارت شعبين، اليهود الذين تثقّلوا بنير الحرف القاتل فصاروا كالثور في حفرة الهلاك، والأمم قد امتلئوا غباوة خلال العبادة الوثنية فصاروا كالحمار الذي بلا فهم... أفلا يهتم الله بخلاصهم ليهبهم سبتًا حقيقيًا، وراحة على مستوى أبدي؟! هذا ويرى القديس أغسطينوس أن المريض بالاستسقاء كلما شرب ماءً يزداد عطشًا، لأن الماء يُفرز عن الدم، هكذا مُحب الغنى كلما نال من البركات الزمنيَّة زاد عطشه إليها بلا شبع إذ يقول: [بحق يقارن المريض بالاستسقاء بالغني الطمّاع. الأول كلما نال رطوبة غير طبيعيَّة زاد عطشه هكذا الغني الطامع نال غنى بفيض يسيء استخدامه فيزداد شغفًا لمحبَّة الغنى[572].] يقدَّم لنا الإنجيلي إبراء هذا المريض بالاستسقاء، قائلًا: "فأمسكه وأبرأه وأطلقه" [4]. إنها ثلاث مراحل يجتازها الإنسان لينعم بعمل السيِّد المسيح الخلاصي، وهي: أ. أمسكه: إن كان المرض قد أمسك بحياتنا، فنحن نحتاج إلى كلمة الله، الطبيب الحقيقي الذي نزل إلينا لكي يمسك بنا، فنكون في حوزته، نقبل الالتصاق به والدخول إلى الشركة معه. يمسكنا الرب بكشفه عن أسرار حبه خلال الصليب، فيأسر حياتنا ويمتص كل مشاعرنا وأحاسيسنا لحسابه كما قدَّم حبه لنا، فنقول: "حبيبي لي وأنا له" (نش 2: 16). ب. أبرأه: إذ يمسك بنا ونحن به، ننعم بخلاصه فنبرأ من خطايانا... بمعنى آخر لقاؤنا معه يقوم على الصراحة الكاملة، نعترف له بخطايانا لننهل بالمغفرة ونتمتع بأعمال محبَّته الخلاصيَّة بلا انقطاع. ج. أطلقه: غاية الالتقاء مع المخلِّص أن نتمتع بانطلاقة الحريَّة كأولاد الله، لكي نوجد على الدوام ثابتين فيه، ونحسب ورثة الله أبينا ووارثون مع المسيح (رو 8: 17). هذا هو عمل السيِّد المسيح فينا: نلتقي به مُمسكين بمحبَّته، نبرأ به من خطايانا، نتحرَّر كأولاد الله لنوجد فيه أبديًا. 2. عدم اشتهاء المتكآت الأولى إذ أراد لنا السيِّد المسيح أن نقبل صداقته لنا سألنا أن نرتفع فوق الحرف، فلا نحفظ السبت بطريقة ماديَّة جافة، وإنما بطريقة روحيَّة لننعم بالراحة الأبديَّة، بإبرائنا لا من مرض الاستسقاء بل من كل خطيَّة، وتحريرنا لنوجد معه أبديًا، هذا ما رأيناه في العبارات السابقة، أما الآن فكصديقٍ لنا يريدنا أن نحمل سماته فينا حتى نقدر أن نلتقي معه، ولعل أهم هذه السمات هي التواضع وعدم محبَّة المتكآت الأولى. إنه لا يدعونا لعدم اشتهاء هذا الموضع لإذلالنا ولا ليقلل من كرامتنا، وإنما لأنه إذ اتضع واحتل المركز الأخير "كعبدٍ"، أرادنا أن نشتهي هذا المركز لنوجد معه خلال روح التواضع المملوء حبًا. بمعنى آخر سعْينا للمتكأ الأخير لا يقوم على شعور بالنقص ولا عن تغصب، وإنما عن حب حقيقي لحمل المسيح صاحب المتكأ الأخير. فيتجلَّى فينا، وتعلن سماته بقوَّة مشرقة على من حولنا، فيصير ذلك سرّ مجد داخلي في الرب. "وقال للمدعوين مثلًا، وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكآت الأولى، قائلًا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرسٍ، فلا تتكئ في المتكأ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دُعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانًا لهذا، حينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير"[7-9]. * ربما تبدو مثل هذه الأمور للبعض تافهة ولا تستحق إعارتها الانتباه، لكن متى ركز الإنسان عيني ذهنه عليها فسيتعلم من أي عيب تخلّص الإنسان، وأي تدبير حسن توجده فيه. فإن الجري وراء الكرامات بطريقة غير لائقة لا تناسبنا ولا تليق بنا، إذ تظهرنا أغبياء وعنفاء ومتغطرسين، نطلب لا ما يناسبنا بل ما يناسب من هم أعظم منا وأسمى. من يفعل هذا يصير كرهًا، غالبًا ما يكون موضع سخريَّة عندما يضطر بغير إرادته أن يرد للآخرين الكرامة التي ليست له... يلزمه أن يعيد ما قد أخذه بغير حق. أما الإنسان الوديع والمستحق للمديح الذي بدون خوف من اللوم يستحق الجلوس بين الأولين لكنه لا يطلب ذلك لنفسه بل يترك للآخرين ما يليق به، فيُحسب غالبًا للمجد الباطل وسيتقبل مثل هذه الكرامة التي تناسبه، إذ يسمع القائل له: "ارتفع إلى فوق" [10]. إذن العقل المتضع عظيم وفائق الصلاح، يخّلص صاحبه من اللوم والتوبيخ ومن طلب المجد الباطل… إن طلبت هذا المجد البشري الزائل تضل عن طريق الحق الذي به يمكنك أن تكون بالحق مشهورًا وتنال كرامة تستحق المنافس! فقد كُتب: "لأن كل جسد كعشبٍ، وكل مجد إنسان كزهر عشب" (1 بط 1: 24). كما يلوم النبي داود محبي الكرامات الزمنيَّة، قائلًا لهم هكذا: "ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يُقلع" (مز 129: 6). فكما أن العشب الذي ينبت على السطح ليس له جذر عميق ثابت لذا يجف سريعًا، هكذا من يهتم بالكرامات الدنيويَّة بعد أن يصير ظاهرًا في وقت قصير كالزهرة يسقط إلى النهاية، ويصير كلا شيء. إن أراد أحد أن يسبق الآخرين فلينل ذلك بقانون السماء، وليتكلل بالكرامات التي يهبها الله. ليسمو على الكثيرين بشهادة الفضائل المجيدة، غير أن قانون الفضيلة هو الذهن المتواضع الذي لا يطلب الكبرياء بل التواضع! هذا هو ما حسبه الطوباوي بولس أفضل من كل شيء، إذ كتب إلى أولئك الذين يرغبون في السلوك بقداسة: احبوا التواضع (كو 3: 12). وقد مدح تلميذ المسيح ذلك، إذ كتب هكذا: "ليفتخر الأخ المتضع (المسكين) بارتفاعه، وأما الغني فبتواضعه لأنه كزهر العشب يزول" (يع 1: 9-10). الذهن المتضع والمنضبط يرفعه الله، إذ "القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره" (مز 51: 17). من يظن في نفسه أمرًا عظيمًا وساميًا فيتشامخ في فكره وينتفخ في علو فارغ يكون مرذولًا وتحت اللعنة، إذ يسلك على خلاف المسيح القائل: "تعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب" (مت 11: 29). كما قيل: "لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (1 بط 5: 5). لقد أظهر الحكيم سليمان في مواضع كثيرة الأمان الذي يحل بالذهن المتضع، إذ يقول: "لا تنتفخ كي لا تسقط" (ابن سيراخ 1: 30)؛ كما يعلن ذات الأمر بطريقة تشبيهية: "المعلي بابه (بيته) يطلب الكسر" (أم 17: 19). مثل هذا يبغضه الله بعدل إذ يُخطئ في حق نفسه ويود أن يتعدى حدود طبيعته بغير شعور… أسألك، على أي أساس يظن الإنسان في نفسه أمرًا عظيمًا...؟! ليت كل إنسان ينظر إلى حاله بعينين حكيمتين فيصير كإبراهيم الذي لم يُخطئ في إدراك طبيعته بل دعي نفسه ترابًا ورمادًا (تك 18: 27)[573]. القديس كيرلس الكبير * هل ترفض أن تتواضع وأنت بالفعل ساقط؟! شتان ما بين من يتضع ومن هو بالفعل ساقط على الأرض. أنت مُلقى على الأرض، أفلا تريد أن تتواضع؟![574] القديس أغسطينوس * لا يحصل طالب الكرامة على ما يطمع فيه إنما يعاني من خيبة أمل، وإذ يشغل نفسه بكيفيَّة تثقله بكرامات إذا بها يجد إهانات. وإذ لا يوجد شيء أفضل من التواضع لذلك يقود السيِّد السامع له لا إلى رفض طلب الأماكن المرموقة، وإنما يوصيه بالبحث عن الأماكن المتضعة[575]. القديس يوحنا الذهبي الفم * لا يظن أحد في وصايا المسيح هذه أنها تجعله شخصًا تافهًا غير مستحق لسمو كلمة الله وجلالها. الأب ثيؤفلاكتيوس هذا ويحذِّرنا القديس باسيليوس من إساءة فهم كلمات السيِّد المسيح، فإنه طلب منا ألا نشتهي المراكز الأولى بل نطلب المتكأ الأخير، لكننا نطلبه بهدوء وفي تواضع ونظام لا خلال العنف أو حب الظهور، فإن سألنا صاحب الدعوة أن نأخذ المتكأ الأول نقبل بهدوء أيضًا ولا نفسد نظامه... بمعنى آخر أن كلمات السيِّد تمس أعماق القلب لكي لا يشتهي الإنسان المجد الباطل، سواء جلسنا هنا أو هناك. الله يطلب القلب لا المظهر الخارجي. لذلك ختم السيِّد المثل بقوله: "لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع" [11]. يمكننا أن نقول بأن صاحب العرس أو الوليمة هو رب المجد يسوع نفسه الذي دعانا جميعًا لنتكئ في كنيسته، الوليمة المفرحة للنفس، فيجتاز في وسطها بلا توقف لأنها مقدَّسة ليرى أصحاب القلوب المتواضعة، فيفيض عليهم من ثمر روحه القدُّوس بغنى، ويرفعهم في أعين السمائيين والأرضيين، وكما قالت القدِّيسة مريم حين قبلت صاحب الوليمة في أحشائها: "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين" (لو 1: 52). 3. اتساع القلب للمحتاجين إذ قدَّم لنا السيِّد بتواضعه أساسًا بقبول صداقته أن نحمل فينا فكره، فنسلك بروح التواضع طالبين المتكأ الأخير، مشتهين ترك المتكآت الأولى لإخوتنا، مقدَّمين بعضنا البعض في الكرامة (رو 12: 10)، الآن يسألنا أيضًا أن نتمثل به بكونه صديقنا السماوي فنحمل قلبًا متسعًا للمحتاجين والمعوزين والمعوقين والمطرودين. إن كان الرب في تجسده قد جاء إلى الإنسان الضائع تاركًا خليقته السماويَّة، أي التسعة والتسعين حَمَلًا ليطلب الخروف الضال، محتملًا بالحب آلام الصليب ليرفعه علي منكبيه ويحمله إلى مجد سماواته، هكذا يليق بنا أن نبحث عن كل محتاج وذليل. "وقال أيضًا للذي دعاه: إذا صنعت غذاءً أو عشاءً فلا تدع أصدقاءك ولا أخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لئلاَّ يدعوك هم أيضًا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة، فادع المساكين الجدع العرج العُمي. فيكون لك الطوبى، إذ ليس لهم حتى يكافؤك، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار" [12-14]. * إن كنا نخجل من هؤلاء الذين لا يخجل منهم المسيح، فنحن نخجل من المسيح نفسه بخجلنا من أصدقائه. لتملأ مائدتك من العرج والمشوهين، فإن المسيح يأتيك خلالهم لا خلال الأغنياء[576]. * إن دعوت صديقًا يبقى يشكرك حتى المساء، لكن الصداقة تبقى إلى حين وتنتهي سريعًا جدّا فلا توازي ما تكلفته من مصاريف. أما أن دعوت فقيرًا أو مشوهًا، فإن الشكر لا يفسد، لأن الله يذكره لك أبديًا، لن ينساه، إذ يكون هو نفسه مدينًا لك[577]. * لنتبع الصداقات التي حسب الروح لأنها قويَّة ويصعب حلها، وليس الصداقات التي تقوم حول المائدة[578]. * كلما كان أخونا متواضعًا يأتي المسيح خلاله ويفتقدنا. لأن من يستضيف إنسانًا عظيمًا غالبًا ما يفعل هذا عن مجدٍ باطلٍ... ليتنا لا نطلب القادرين أن يكافؤننا، بل نتبع القول: "فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافؤك". ليتنا لا نضطرب حينما لا يُرد لنا اللطف باللطف، لأننا إن تقبلناه من الناس لا ننال ما هو أكثر، أما إذا لم يُرد لنا من البشر فالله يرده لنا. * يليق بك أن تستقبل (الفقراء) في أفضل حجراتك، فإن أحجمت عن هذا فلا أقل من أن تتقبل المسيح في الحجرات الدنيا حيث يوجد الذين يقومون لك بالأعمال الحقيرة والخدم. ليكن الفقير علي الأقل حافظًا بابك، لأنه حيث توجد الصدقة لا يقدر الشيطان أن يقتحمه ويدخل. إن لم تجلس معهم، فعلى الأقل ارسل لهم الأطباق من مائدتك[579]. القديس يوحنا الذهبي الفم يستعرض القديس كيرلس الكبير[580] تعليقاته علي هذا المثل قائلًا بأن المهتمين بتقديم صور جميلة لا يكتفون باستخدام لون واحد، هكذا إله الجميع واهب الجمال الروحي ومعلمه يزين نفوسنا بفضائل متنوعة لنحمل حياة مقدَّسة من جوانب متنوعة [ليكمل فينا شبهه.] لهذا أمر السيِّد المسيح الناموسيين والفرِّيسيِّين والكتبة أن يسلكوا بروح التواضع ويتحرَّروا من محبَّة المجد الباطل وألا يطلبوا المتكآت الأولى، والآن يطلب منهم محبَّة الفقراء، فلا يستضيفوا في ولائمهم الأغنياء لطلب المديح وحب الظهور بل المحتاجين والمعوقين والمتألَّمين بكل أنواع الأمراض الجسديَّة للحصول علي الرجاء في العلويَّات من الله نفسه. يكمل القديس كيرلس الكبير حديثه عن هذه الفضيلة التي تزين النفس، قائلًا: [الدرس الذي يعلمنا إيَّاه هو حب الفقراء، الأمر الثمين في عيني الله... هل تشعر بالسرور عندما يمدحك أصدقائك وأقاربك الذين تستضيفهم في الوليمة؟ أخبرك بما هو أفضل، فإن الملائكة تمدح سخاءك، والقوات العلويَّة العاقلة والقدِّيسون يفعلون ذلك، بل والله أيضًا يقبل هذا الذي يسمو بالكل ويحب الرحمة وحنون. اقرضه ولا تخف، فسيرده إليك ومعه ربا، إذ قيل "من يرحم الفقير يقرض الرب" (أم 19: 17). أنه يعرف القرض ويعد بالوفاء به (مت 18: 23 الخ)... اقتن النعمة النابعة عن الله. اقتن لك رب السماء والأرض صديقًا، فإنه بالحق يقتني الإنسان صداقة البشر غالبًا بذهبٍ كثيرٍ، فإن تصالح معنا أصحاب الرتب العاليَّة نشعر بفرحٍ عظيمٍ بتقديم هدايا أكثر من طاقتنا بسبب نوالنا كرامة الالتصاق بهم، ومع هذا فإن هذه الأمور زائلة، تنتهي سريعًا تعبر كخيال الأحلام. ألا يليق بنا أن نحسب عضويتنا في بيت الله تستحق أن نقتنيها؟ أما نحسبها أمرًا عظيمًا؟! فبالتأكيد بعد القيامة من الأموات سنقف في حضرة المسيح، وتُقدَّم المكافأة للمترفقين والرحماء، وتكون الدينونة قاسيَّة علي العنفاء الذين لم يكن لهم الحب الطبيعي... إذ قيل: "لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة" (يع 2: 13).] أما العلامة أوريجينوس فإذ يأخذ بالتفسير الرمزي. يرى في الوليمة، المائدة الروحيَّة حيث يليق بنا نطرد عنا المجد الباطل ونستضيف الفقراء أو المساكين أي الجهلاء الذين تعوزهم الحكمة، لكي يجدوا في مائدتنا السيِّد المسيح الذي يغني الكل. ونستضيف الضعفاء الذين يقاومون الضمير الداخلي لكي يبرأوا داخليًا. كما نستضيف العرج، أي الذين ضلّوا عن السلوك في الحق لكي يجدوا الطرق المستقيمة في الرب؛ ونستضيف العُمي الذين ليس لهم بصيرة روحيَّة لإدراك الحق لكي يتمتعوا بالنور الحقيقي... هؤلاء ليس لهم ما يكافؤننا به إذ لا يجدوا ما يجيبون به علينا أمام الكرازة المملؤة حبًا!

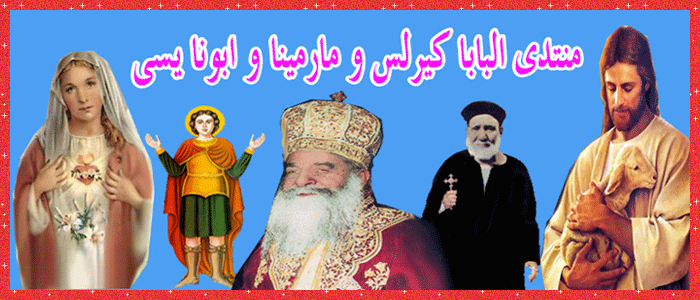











 الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف
الأحد 30 يونيو 2024, 10:20 am من طرف 











